الأخبار الكاذبة لليمينيين وسقوط كذّابي الليبرالية!
تثور قضيةُ الأخبار الكاذبة في الإعلام الأميركي اليوم، ذلك أن الحزب الديمقراطي يُحمِّلُ هذه الأخبار جزئيا مسؤولية خسارته الانتخابات لصالح دونالد ترمب. ومن تلك الأكاذيب قصة إداريٍّ في حملة هيلاري كلينتون تناول الطعام في مطعم بيتزا بالعاصمة، ولكن فكرة شيطانية خطرت على عقل ما، فزعم وجود أنفاق تحت المطعم يتاجر فيها الديمقراطيون -وهيلاري منهم على التحديد!- بالأطفال.
ولشدة ما تُدُووِلَت هذه الفرية صدَّقَها أحد المواطنين فسافر ببندقية إلى هذا المطعم قاصدا تحرير الأطفال المختطفين ومُطلِقاً النار على المحل ثم اعتقِل، ليتبين عمق الكذبة وأثرها على من يصدقها.
وليست هذه بكذبة موتورة.. بل هناك الكثير، خصوصا ما يدور على لسان ترمب نفسه حيث يعلل زيادة هيلاري عليه بقرابة ثلاثة ملايين صوت بكون كثير من هذه الأصوات غير قانونية، وهو أمر متعذر عمليا، ولا دليل عليه أصلا. لا بل تمادى ترمب فأطلق دعاوى مرسلة لا يُعرف لها سندٌ في الواقع، حتى ذهب البعض إلى أننا نعيش في عصر "ما بعد الحقيقة".
الأخبار الكاذبة ورطة عُظمى يحاول الإعلام الليبرالي العتيق تصويرها بأنها اختلاق جديد للإعلام اليميني في عصر تويتر وفيسبوك، ويطلب من هذه المنابر ابتكار آليات للتحذير من هذه الأخبار. والحق أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، وهو ما سأشخصه هاهنا.
ثنائية الصدق والكذب ليست بالاكتشاف الجديد، فما كان للإنسان أنْ يخطَّ طريقه التطوري الطويل دون السعي الحثيث لما يَصدُقُ من الأقوال والنبذ لما هو كاذب منها. وحسبك أن الكائن البشري الذي غلبت عليه السذاجة وقَبِلَ بالأكاذيب لا يلبث أن يؤذيه الكذب طفلا أو كهلا.
فمن قفز في بئر صدّق أنها غير عميقة غرق فيها، ومن صدّق أن وضع الرأس في فم تمساح جائع يشفيه من الصداع فقَدَ صداعَه ورأسَه بالمعية! فإذا كان انتباه العقل للصدق هو أسٌ من أسس عقلانية الكائن البشري وإدراكه لاتصال الأقوال بالموجودات، فإن محبة الصدق صارت كغريزة محبة الطعام الطيّب، وكراهية الكذب صارت كغريزة النفرة من الطعام المنتن.
ضمن هذا التأصيل الغريزي، فلا عجب أن "الكذّاب" وصفٌ قدحي في الأخلاقيات البشرية جميعها، الملحد والمتدين فيها سيان. ولا غرابة أن يكون فلاسفة الحداثة في بواكيرها منافحين عن غاية الصدق، فراموا جعل كل المعارف على شرط الصدق الذي تمليه العلوم الطبيعية.
وتحرِّي الصدق في فهم العالم واجتناب الكذب يكون على ضربين: فإما أن يكون كذبا بالاقتراف كأن نقول إن "الصين اليوم أصغر من اليابان سكاناً" وهو كذب صريح، أو أن يكون كذبا بالحذف والتعامي كقول القائل "إن المعدة أصلُ كل داء"، وهو تعميم لا يتطرق للالتهابات والأمراض المعدية والسرطانات التي تصيب الجسد دون أن تكون لها صلة بالمعدة تحديدا، فكان القول كاذبا بتعميمه الفاسد.
وهكذا بحث المناطقة في صدق الأفكار، والأخلاقيون في صدق القيم، والمؤرخون في صدق الحوادث، ولا يزال اشتغال هؤلاء الفلاسفة العلميين لا ينقطع، فتراكمت الحقائق الصلبة والتقنيات الناجعة.
على الضد من التأصيل الغريزي والأخلاقي والمعرفي للصدق، ظهر من يشكك في وجود الصدق أصلا. فالحقيقة هي ما تمليه إرادة القوة عند فريدريك نتيشه، أو هي أداة للهيمنة الذكورية عند ساندرا هاردينغ، وهي ما يؤطره الإعلام في عقل الجماهير عند وزير الإعلام النازي جوزيف غبلز.
هذا التحول الخطير صار مذهبا لدى "ما بعد الحداثة" في كون الحقيقة والصدق اختلاقا اجتماعيا، وهو أمر تنشرح له صدور أصحاب السلطان. فإذا كان الكهنة في الماضي قادرين على إقناع الأقنان بالخنوع والكدِّ لصالح الطبقة المالكة طمعا في خلاص روحاني، فإن عصر الطباعة والمذياع والقنوات التلفزيونية صار يغير اللعبة. فتوجيه العقول صار أوسع وأكثر تدفقا، ومَنْ مَلَكَ ما تسمعه الآذان وما يُلقَى على الأبصار، صار عالما بما توسوِسُ به النفوس.
هكذا صار التوجيه الإعلامي ركنا للدولة الحديثة. وآلَ استمرارُ السلطات الحاكمة -شيوعية أو رأسمالية، ملكية أو جمهورية- مرهونا بالقدرة على التوجيه الجماهيري للفضاء المعلوماتي. فمن مَلَكَ التوجيه المعلوماتي ملك القلوب، ومن مَلَكَ القلوب خضعت له الأجساد بثرواتها وقواتها.
لا عجب أن الكذب صار حِرفةً حكومية لا تقوم الدولة بغيره، فالشيوعيون يكذبون لصالح مذهبهم، وكذا الرأسماليون يختلقون من الأكاذيب ما يفلُّ أكاذيب خصومهم، ووحدها الحقيقة صارت منحصرةً في خبراء مكبوتين أو في مكاتب المخابرات وصناعة القرار الأعلى.
لقد كانت لعبة الكذب العمومي مُستَتِبَّةً لأصحابها حتى حين. لكن حبل الكذب قصير ولا يلبث أن تقطعه اختبارات الغرائز والأخلاقيات والمعارف. فلا يمكن إقناعُ الجائع بأنه شبعان، ولا المعذَّب بأنه يعامل بالأخلاق الحسنى، ولا القولُ بأن ماء البحر ينخفض بينما الجزر تغرق؛ إذ الغرائز والأخلاق والمعارف تقف بالمرصاد.
هكذا ظهرت الثورة المعلوماتية أواخر القرن العشرين، فأخذت المعلومات والصور والأفلام تتدفق، وزادت مواقع التواصل الاجتماعي من بثها، فكيف للحكومات أن تسيطر على كل ما يتدفق؟ لم يعد الأمر بسهولة السيطرة على قناة تلفازية واحدة وإذاعة مفردة وجريدة محورية، في عصر جاز فيه لكل مواطن أن يؤسس واحدةً من كل ذلك بنفسه.
هكذا تفطَّنَ خصوم الطبقة الأميركية الحاكمة من الأصوليين والقوميين والعنصريين إلى أنه يجوز قلب سحر كذابي الليبرالية الجديدة عليهم، بمن فيهم أصحابُ المصارف والإعلاميون وأرباب الترفيه ودعاة العولمة، لإرجاع الأمور لصالح الدولة القومية نخبوية السلطة وأحادية الثقافة.
فأخذ بعض هؤلاء اليمينيين يبثون من الأكاذيب ما أقنع بعض العامة بالتحول عن الإعلام الأميركي الليبرالي إلى ما هو أكذب منه. لكن ويا للعجب، فإن الكذب المستجِد الذي أسهم في خسارة هيلاري ما هو إلا حفرة حفرتها النخبة الليبرالية في أميركا منذ زمن بعيد، فما لبثت أن وقعت فيها.
ولا يمكن حل مشكلة الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بحل مشكلة الكذب الأكبر في المقولات الثقافية العامة في الغرب. وأخصُّ الأكاذيب التالية التي تمهد مكافحتها لاستئصال جذور الكذب الأكبر، حتى تتلاشى أغصان الكذب الأصغر المعتاشة على تلك الجذور:
1- الرأسمالية الفردية هي الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية: وهذه الكذبة ترى إطلاق أيدي أصحاب رأس المال في المشاريع والربح دون قيود. وهذا المذهب لا يصح من الناحية الهندسية البسيطة، ذلك أن رأس المال الفردي لا يمكن أن يزدهر دون شبكات المواصلات والاتصالات، فضلا عن العمالة المنضبطة بالقانون والسليمة صحيا، والمتعلمة القادرة على الابتكار التقني والانضباط الإداري المعقد للإنتاج.
ومعلوم أن المجتمع والدولة هما اللذان يقدمان كل تلك البنى التحتية الكبرى للرأسمالي، وبغير الرأسمالية الاجتماعية لا يفلح رأس المال في تطوير المشاريع ولا تسويقها، فضلا عن تحقيق الأمن الشخصي لصاحب رأس المال ومشروعه.
ولذلك تُوجِبُ الرأسمالية الاجتماعية ضبط عملية التربُّح بمصالح المجتمع وبالمساهمة الضريبية في البنى التحتية التي يستغلها الرأسمالي. وليجرب الرأسمالي نقل رأسماله إلى بقاع من العالم الثالث خالية من البنى التحتية فهل سيحصل على أرباحه تلك؟
2- الديمقراطية الشكلية هي النظام السياسي الأكفأ لممارسة السلطة: وهذه الكذبة ترى أن الديمقراطية النيابية هي نهاية التقدم في الإدارة السياسية. لكن حكم الشعب مرهون بالممثلين في معظم الديمقراطيات، وهؤلاء يقنعون المقترعين ببرامجهم من خلال الإعلام، وكلا الأمرين مقيد بدستور خطته نخبة سابقة تؤطر دوائر الانتخاب وتداول السلطات ونظام التقاضي.
ومن أمسك بالتوجيه الإعلامي، والتمثيل النيابي للمقترعين، واستمر في فلك الفئة الكاتبة للدستور، صار قادرا على حكم الشعب باسم الشعب ودون استئذان الشعب، وامتلاك زمام الثروة والسلطة جميعها، وهذا حال الديمقراطية المفرغة.
من الجلي أن أي حاكمية شعبية تلزمها مراجعة مستمرة للعقد الدستوري، وتفكيك دائم لمحاولة تكليس طبقة نيابية، ومراقبة حثيثة للتدليس الإعلامي. أو قل لا ديمقراطية إلا بالحاكمية الشعبية الدوارة مع المصالح المتجددة لأفراد الشعب.
3- المتع الغذائية والجنسية والتفاخرية واللهوية المتحققة بالمال هي الغاية القصوى لحياة الإنسان: وهذه الكذبة متفرعة عن الكذبتين السابقتين، وموجهة للجمهور المندفع للتسابق في الزيادة من الأموال كمعيار للسعادة. ولا مجال لمعاندة فطرية إشباع المُتع البشرية ودورها الأساسي في توجيه الاقتصاد السياسي، ذلك أنه راجع في أصوله للصراع على إشباع الحاجات والرغبات الفردية؛ لكن أساليب تحقيق السعادة محل شك.
فمن ذا الذي قرر أن يوم العمل هو ثماني ساعات (مع أن خمس ساعات تعادلها في الإنتاجية وتزيد عليها في بحبوحة معاش الموظفين)؟ وأن حرق الوقود يجب أن يستمر حتى إفناء الآبار وخنق الكوكب (مع أن الطاقة البديلة متوافرة)؟
وأن على المدن الإسمنتية الاستمرار في الزحف ومسح الغابات والأراضي الزراعية حتى لا تبقَ خضرة تتنفس منها (مع أن عمل الناس في البلدات الصغيرة التي يسهل فيها التنقل مشياً صار ممكنا بالربط الشبكي دون التكدس في المدن)؟ وأنه على المرء حشو معدته بالأطعمة الرخيصة المصنَّعة والمسرطِنة (مع أن القليل الطازج طيب المذاق يفي بالإشباع ويمنع الأمراض ولو كان أغلى ثمنا)؟

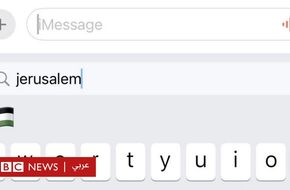







Comments