سفيان الغانمي يكتب: عن معشوقتي الأولى «فلسطين» | ساسة بوست
منذ 1 دقيقة، 20 أبريل,2017
قبل أن أبث إليكم مكنون حبي لتلكم البلاد البعيدة والقريبة في نفس الآن، هي بعيدة مكانًا لكنها لا تبرح خالدي في الآن نفسه، قبل أن أرمي إليكم بمكنوناتي تجاهها، لا بد وأن أقدم اعتذاري لكل ابن من أبنائها ما زالت تحتضنه جغرافيتها، أو كتب عليه القدر العيش بعيدًا عن أحضانها، لكل من يتوق لرؤيتها، ومن أضناه الشوق وهم العودة والرجوع إليها.
أنا لم أذهب إليها يومًا ما، ولست ممن ينتسب إليها، أنا مجرد عاشق سكنه هواها، وأعوزته الحيل للوصول إليها، ولولا حبها الذي يقيم بين ضلوعي، وحكاياتها الحزينة التي ظلت رابضة بين جوانحي، ما تجرأت لأسيل مداد قلمي بين أقلام فرسانها الأبطال، لكن ربما حب عاشق يغفر له زلته.
لا زلت أتذكر وأنا طفل لم يكمل ربيعه السابع بعد أو الثامن، صورة معلقة على جدار بيت عمي وقد علا الغبار واجهتها الزجاجية، كان يتوسط الصورة قبة ذهبية لامعة، وأشعة الشمس تبدو منعكسة عليها، كلما كنت أسأل أبي عن تلك الصورة يرد باقتضاب إنها القدس، ثم يطرق رأسه دون أن ينبس ببنت شفة، ويتركني حائرًا لأسئلتي البريئة، كنت أردد مع نفسي ما القدس هذه؟ لكن ما كان يتبخر طيف تلك الصورة وأسئلتها من ذهني، بمجرد أن أخرج للعب مع الأطفال.
داخل مقصف إحدى المدارس التي كنت أدرس بها، كان هناك تلفاز كبير، وأثناء تناولنا وجبة الغداء، كنا نشاهد إحدى القنوات الفضائية وهي تعرض صورًا لأناس خيم البؤس والشقاء بين مساكنهم، أناس جاورهم الألم وصاهرهم الذل والعذاب، هكذا كنت أرى تلك المشاهد التي أبت أن تنمحي من ذاكرتي، كانت تلك الصور تظهر أطفالًا رضعًا ولطخات من الدم تعلو وجوههم، وأخرى لشباب محمولين على الأكتاف، وهم بين مفارق للحياة وآخر مبتور الساق أو إحدى اليدين أو كلتيهما، ووراءهم نساء ورجال يصرخون على حد سواء، ولا أحد يسمع أصواتهم، ولا أنا! كنت أشاهد الصور صامتة مرفقة بموسيقى حزينة.
بعدما بدأت أتقدم في سنوات دراستي، بدأ يتشكل لدي وعي ببعض تلك الأمور التي كانت تثير أسئلة في ذهني وأنا لم أبرح موطن الطفولة بعد، بدأت أعي أن تلك الصورة لم تكن للقدس، بل كانت صورة لقبة الصخرة الشريفة، أما أولئك الأطفال الذين كنت أشاهدهم وأنا طفل في نشرات الأخبار وهم يرمون الحجارة «بالمقلاع»، أو يرمون بعض قطع الإطارات المشتعلة على الدبابات، أو أولئك الأطفال الرضع، أو الشباب الذين يحملون على الأكتاف وهم مبتورو الأطراف، فبدأت أتتبع حكاياتهم عبر تلافيف الزمان الغابر، كنت أسمع من أساتذتي نتفًا من حكاياتهم مبتورة، جزءًا من ذا وآخر من ذاك، لكن كل تلك النتف من الحكاية كانت تشكل لدي مفهومًا واحدًا، وهو أن هؤلاء الفلسطينيين كان عندهم في يوم ما وطن، بل كانت عندهم حكاية قديمة قدم أرضهم في الوجود، قبل أن يغتصبها منهم عدو قديم، عدو ليس لهم فقط، وإنما عدو أخذ على عاتقه تدمير وتخريب كل ما تطاله يده، وكأنه جراد منتشر.
هكذا كانت تترسخ في ذهني صورة أولئك الجرذان الذين خلقهم الله على هيئة إنسان، فعندما كنت أحفظ القرآن كنت أمر ببعض قصص الأنبياء فيه، مثل موسى، وعيسى، ويونس، وإبراهيم، وغيرهم كان شيخي يشرح لي تلك القصص بلغتي الدارجة، كان أسلوبه يجعلني أتخيل ذاك الزمان وكأني أعيشه، حينها كنت أستغرب لما يحكي لي ما حصل لهم مع كليم الله موسى، وكيف عاندوه وخالفوا أوامر ربهم التي تحتهم عليهم اتباع رسله، حتى سلط الله عليهم ألوانًا من العذاب، من التيه، والقمل، والضفادع، والدم، وغيرها. وكان يذيل كلامه بقوله: هذا حالهم مع الله ورسله فكيف سيكون حالهم مع عباده!
هكذا كانت تنسج الحكاية في ذهني عن فلسطين، كانت معارفي بها تنحصر بين ما أسمعه من أساتذتي، أو ما كنت أراه من حين لآخر من تلك الصور التي تبثها القنوات، أو ما أسمعه من شيخي الذي حفظت عنه القرآن، من حكايات لقصص الأنبياء مع ذاك الشعب الذي اغتصب أرض الفلسطينيين.
بعد مدة بدأت أشاهد وثائقيات مطولة عن فلسطين القديمة، فلسطين الخالية من الحياة، ليست تلك التي كنت أشاهدها عبر التلفاز، بل فلسطين أخرى، المدينة التي ما زالت تحتفظ بمعالمها القديمة، فلسطين التي ما زالت تحتفظ بتلك المعالم الضاربة في القدم، معالم تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، بل لعلها قديمة بقدم الإنسان.
وقتها سكن حب ذاك البلد قلبي، وظل هواه يسري في شراييني، أتذكر وأنا أتابع تلك المشاهد، وأردد مع مذيع القناة أسماء تلك الأماكن واحدًا بعد الآخر، ما زلت أتذكر أسماءها جيدًا، مثل: حيفا، عكا، الخليل، يافا، كلها مدن عتيقة ضاربة في التاريخ، لم تكن مأهولة بالسكان، بل أضحت معالم أثرية يستغلها الأدباء والفنانون اليهود، لكن آثار الحزن كانت ما تزال بادية على محياها، جراء ما شهدته من تهجير، وتقتيل، وتشريد جماعي، هذا ما كان يحكيه شيخ تعتلي وجهه تجاعيد، وكأنه قشرة شجر البلوط، وعلى رأسه كوفية وهو متكئ على عكازه المعقوف.
من حينها وصور تلك المدن خالدة في ذهني، فأصبح حبي لها يتضاعف يومًا بعد آخر، أصبحت أشعر بالحنين إليها وكأني ولدت بين كنفها، ثم هجرت مع تلك الجموع التي خرجت سنة 48 تجر أذيال الخيبة وراءها، بل بت أتخيل نفسي بين أولئك الأطفال الذين يرمون الجيش بالحجارة أو قطع إطار السيارات المشتعلة، أو أتخيلني وأنا أرتدي بدوري كوفية وذاك الشيخ يمسك بيدي ويتجول بي داخل أحياء القدس القديمة، ويحكي لي بلغته المحلية قصص تلك المعالم التي ظلت صامدة في وجه الزمان، آبية الاندثار أو التغيير، رغم ما يطالها من تزييف متمعد من طرف اليهود كل يوم.
هكذا ظل هاجس فلسطين يسكنني، فقررت تعزيز معرفتي الثقافية بها، سألت أحد أساتذتي عن كتاب مبسط عنها، فاقترح عليّ كتابين للدكتور طريق السويدان، كانا عن تاريخ فلسطين المصور، وتاريخ اليهود المصور، ما زلت أتذكر كيف أقبلت بنهم على الكتاب الثاني، ختمته في يومين، وأثناء قراءتي له، كنت كمن يتجول عبر الزمان في تاريخ ذاك البلد منذ القدم، كيف دخل اليهود إليه أول مرة وكيف خرجوا، بل وكيف امتنعوا عن دخولها عندما أمرهم ربهم.
وبعد انتهائي مباشرة ثنيته بالآخر، آلمني فيه كثيرًا حكاية مجزرة دير ياسين،ما زلت أتذكر كيف كنت أردد تلك الكلمات التي تصف تلك المجزرة، وقطرات الدمع تنزل من عيني.
لاحقًا ستصبح معرفتي بذاك البلد، لا أبالغ إن قلت أكثر من بلدي، حتى أصبح لدي شعور المغترب عن بلاده، وأنا بين أحضانه أتنعم بخيراته، بل أصبحت أشعر وكأني واحد من أولئك الأطفال المشردين داخل المخيمات، الذين يقاسون شتى أنواع الحرمان، لا ماء ولا طعام، لا تمدرس جيد، ولا رعاية صحية، ومع ذلك كان يغريني فيهم ذاك الصمود الأبي، وحلم العودة الذي لا يبرح خالدهم.
وهكذا أضحيت مدمنًا على الوثائقيات التي تعرض تفاصيل الحياة الفلسطينية، وخاصةً منها تلك التي تصور المدن القديمة، كنت أحفظ أسماء المدن القديمة كلها؛ بل وحتى بعض الأزقة فيها، لكن بجانب مشاهدة الوثائقيات، كنت أقرأ أي كتاب يقع في يدي، واسم فلسطين موسوم على غلافه، أغرمت بكتابات كنفاني بعدما أوقعتني في حبه رائعته ما تبقى لكم، بعدها لا أتذكر كيف وقعت في يدي الرواية الشهيرة «آخر أسرار الهيكل»، وكيف ظلت فكرة محتواها الرئيسية راسخة في ذهني، كانت فكرتها الأساس، هي أنه يمكن التعايش بين الشعبين اليهودي والإسرائيلي، لكن تلك الفكرة لم تستهويني ولا غيرت من قناعتي، بل ظللت أرى أن استئصال ورم إسرائيل هو الحل الأمثل لتلك المشكلة الاستعمارية، والتي عبثًا يحاولون أن يضفوا عليها الصبغة التاريخية.
تلك كانت قصتي مع فلسطين مع ما كنت أشاهده وأقرأه، أما الآن فأصبحت أعيش حالة وجد خاص، بعد ما أدمنت على كتابة درويش، وسامح القاسم، وغيرهما، أضحيت عند سماعي لصوت مارسيل خليفة وهو يردد كلمات درويش بصوته الرخيم، يعتريني شعور خاص، وكأني صوفي يرتقي في منازل الإيمان، كانت تلك الكلمات تسحرني وخاصة عندما تكون بصوت ذاك الفنان الخالد، مارسيل خليفة، كان آخر ما قرأت عن فلسطين رواية «مصائر» الحاصلة على جائزة البوكر العربية، فيها تتبعت مصير كل من الفلسطينيين ضحية التهجير القسري الذي فرضه عليهم اليهود، ومصير الأرمن الذين هجرتهم الإمبراطورية العثمانية، ومصير اليهود الذين فروا من المحرقة، تغيرت معالم الحكاية في ذهني، وأصبحت أرى الأمور على خلاف ما كنت أرى في السابق.
أتذكر الآن ربعي المدهون وهو عائد إلى بلاده بعد مدة، بل وأتذكر كيف أن أحد أبطال روايته أوصت بأن يحمل جزءًا من رمادها ليذره في هواء فلسطين، أتذكر جيدًا مشهد ربعي المدهون وهو يتجول بين معالم القدس القديمة، ويحمل بيده هاتفه وصوت فيروز ينبعث منه مرددًا:
لأجلك يا بهية المساكن، يازهرة المدائن.



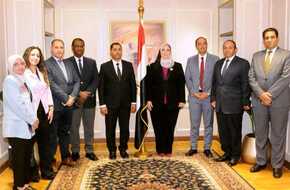



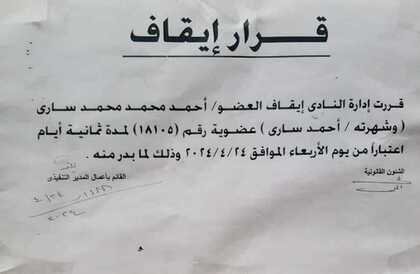

Comments