إيمان عبد المنعم تكتب: الإنسان يبحث عن المعنى – ج(١) | ساسة بوست
منذ 23 دقيقة، 13 أكتوبر,2016
في كتابه صغير الحجم عميق الأثر يشرح د. ڤكتور فرانكل طريقته في العلاج بالمعنى، والتي تتلخص في أن ما يميز الإنسان حقًا هو قدرته على إرادة المعنى والسعي للتسامي فوق الذات وليس مجرد تحقيقها كما الفكرة السائدة.
من بين الأفكار التي طرحها دكتور فرانكل فكرة التوتر الصحي اللازم لكل إنسان سوي النفس كي يحيا حياة أخلاقية ذات معنى.
فخلافًا للرأي القائل بأن غاية النفس البشرية مما تسلكه من أفعال – قد تكون مرضية أحيانًا – هي الاستقرار والسلام الداخلي، يرى دكتور فرانكل أن النفس الإنسانية في الحقيقة لا يرضيها الاستقرار على المدى البعيد إذ يوقعها في ملل وشعور بالفراغ لكنها تتوق دومًا لمثال تطمح إليه أو معنى تبغي تحقيقه وفي هذه الفجوة بين «ما هي عليه» و«ما تصبو لتكون عليه» تكمن الحياة السوية المستقيمة للنفس.
هذه الفكرة نفسها يؤكدها بيجوفيتش مرارًا في كتابه العظيم «الإسلام بين الشرق والغرب» والتي ينظر من خلالها لكل محاولة لإقامة مجتمع طوباوي «الفردوس الأرضي بتعبير المسيري» باعتبارها محاولة فاشلة تؤدي لكوارث تنعدم فيها قيمة الإنسان نفسه، ويرى بيجوفيتش في الكتاب نفسه أنه لابد من تمييز واضح بين عالم القيم والمثل العليا كعالم متجاوز لعالم المادة ومتسامٍ فوقه ومغاير لمعاييره وبين عالم الإنسان «المبتلى بازدواجية الروح والمادة»، والذي تتمثل فضيلته الحقيقية في كدحه المتواصل نحو تحقيق أنبل المعاني والمثل في نفسه أولًا ومجتمعه ثانيًا «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه» (سورة الانشقاق).
لماذا نطرح عليكم هذه الأفكار إذًا؟
لأننا في مجتمعنا المنهك – بكل ما تحمله الكلمة من معنى – انقسمنا لعدة فرق يحاول كل منها فرض رؤيته على الآخر (مع الاعتراف بأن مجرد التفكير في فرض رؤية ما في ظل دولة غاشمة كهذه هو أمر يدعو للسخرية)، من بين هذه الفرق يبرز فريقان أحدهما يرى كل الأمور نسبية بما في ذلك المعاني والقيم ويصير لكل إنسان الحق في أن يفعل ما يعنّ له دون حق لأي فرد في الحكم عليه أو تقييمه، وفريق يرى أن كل الأخلاق الفاضلة والأحلام المستحيلة ممكنة التحقق هنا والآن فقط لو أردنا وعملنا.
أحيانًا أشعر بأن كلًّا من هاتين الرؤيتين مجرد صورة للأخرى رغم التناقض الظاهر بينهما، ففي الحقيقة كلتاهما تجرد الإنسان من إنسانيته (بيجوفيتش مرة أخرى) ويحوله إما لملاك أو شيطان أو حيوان غافل سعيد بحظه من سلم التطور، أركز هنا على فريق المجتمع الطوباوي الذي لا يقتصر فقط على مدربي التنمية البشرية بل يمتد ليضم معظم فئات المجتمع والذي يهمنا هنا أكثر من غيره هو فئة الدعاة وعلماء الدين وطلاب العلم الذين يصطدمون بهذه الأفكار بطريقة أكثر بؤسًا من غيرهم؛ فعلى مواقع التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» و«آسك» وغير ذلك سنجد الشكوى الأكثر تداولًا هي الفتور في العبادة واليأس من الذنوب بعد إقبال على الله والتزام بالعبادات ظاهرًا وباطنًا.
بعد معايشة أكثر من تجربة ومن خلال ما نقلناه من قبل، يمكنني القول إن السبب الرئيسي لهذا الفتور هو الدخول ابتداء في العبادات والطاعات بمنطق «السوبر مان»، هذا الكائن المثالي الذي لا يترك فضيلة إلا فعلها ولا رذيلة إلا اجتنبها ولا علمًا إلا طلبه ولا عمل خير إلا فعله، والذي يحالفه النجاح في كل ذلك طوال الوقت، لا أنكر أن كثيرًا من الأساليب الدعوية (والتي تحولت أحيانًا لمجرد برواز إسلامي للتنمية البشرية) كانت سببًا في ذلك، لكن أيضًا سياق الحياة العام في مجتمع غارق في الفشل يدفع باتجاه النجاح السريع والساحق ملموس النتائج حتى في أشد الأمور بعدًا عن المادة ومقاييسها مثل الإيمان بالله وطاعته والالتزام بدينه، فصار الإنسان مهما بلغت درجة تدينه يولي النجاح المادي عنايته الفائقة وإن ألبس ذلك أحيانًا نوايا طيبة، بل إنه صار يقيس حتى التزامه وتدينه بقدرته على إنجاز أعمال ملموسة ومشاهدة مثل قراءة أجزاء كثيرة من القرآن وصلاة عدد هائل من ركعات النوافل والاستماع لدروس وخطب ومواعظ لا تُحصى، وما أن يحالفه النجاح حتى يخضع له من دون الله و يعتقد – دون وعي أحيانًا – بأن مجهوده وحده هو السبب فيما وصل إليه من درجة تعبدية عالية.
ثم يحدث ما يجب أن يحدث وينتاب الإنسان الفتور والملل والإرهاق، ويضعف أمام بعض المغريات فتتشوه الصورة المثالية التي رسمها لنفسه وييأس من العودة للمحاولة بعد أن لوثته الدنيا ويصير عالقًا في دائرة مغلقة من الفتور واليأس.
والمخرج الوحيد من هذه الدائرة شديدة الضيق هو إقراره التام بالعبودية المحضة لله؛ بأن يعرف الإنسان قدر نفسه ومعنى ما خلق له، فالإنسان المدرك لضعفه البشري ونقصه العقلي ومسئوليته الأخلاقية وطبيعة الحياة التي ابتلي بها يستطيع أن يتعامل مع أوامر ربه عز وجل ونواهيه بمنطق السنة النبوية المطهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ» (الموطأ للإمام مالك).
وقالوا في تفسير «لن تحصوا» أي لن تحصوا ثواب الاستقامة إذا استقمتم، أو لن تقدروا على الاستقامة بحولكم وقوتكم وإنما بفضل الله ورحمته، أو لن تستوعبوا خصال الاستقامة كلها فسددوا وقاربوا فذلك أجدر أن تبلغوا. وهذا المعنى الأخير هو القريب لغرضنا، ففي عصر ضاعت فيه ملامح التمييز بين ما نريده وبين ما نقدر عليه يصير واجبًا على كل منا أن يعرف ما يحسنه ويجعله مدخلًا إلى ما لا يحسنه، لا أن يفتح الأبواب كلها في نفس الوقت دون أن يستطيع أخذ خطوة واحدة للداخل، ولعله من أعظم دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة على توزيع المهام على كل شخص بما يناسبه ويناسب إمكانياته، والاعتراف بأن لكل منهم السبق في أمر يختلف عن غيره كما جاء في الحديث الشريف «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينًا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» (صححه الألباني على شرط الشيخين)، والاعتراف كذلك بأنه ليس ثمة عيب في أن يكون الإنسان عاديًا لا يميزه سوى طاعته لله ورضاه بقدره دون ذكر له ولا سمعة ولا اشتهار.
وبعد، فربما توجب على الإنسان أن يدرك إدراكًا لا لبس فيه أن حياته هنا ليست هي الغاية وأنها كلها مكابدة وكدح إلى الله ومجاهدة في سبيله لنفسه والدنيا والشيطان.

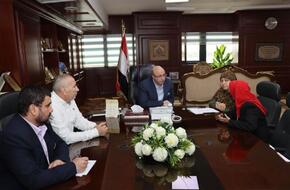







Comments