حازم حسين يكتب: 23 يوليو.. 64 سنة.. ثرثرة مستمرة - الفيومية
الرئيسيه » رأي » حازم حسين يكتب: 23 يوليو.. 64 سنة.. ثرثرة مستمرة
لتكرار آفة، سواء كان لاستزادة أو لفراغ، وأمس كانت ذكرى واحدة من أبرز مناسبات التكرار الممل والممجوج، ذكرى حركة الجيش في 1952، وخلافها المتجدد السطحي، هل كانت ثورة أم انقلابا؟ وما يتبع الخلاف من سيل عرم يتدفق من ألسن الكارهين والمحبين، إما بالتمجيد المطلق، أو اللعنات المطلقة، هكذا بيقين سماوي لا يداخله الشك ولا توسط فيه.
المشكلة القائمة في واقعنا العقلي، فيما يخص ذكرى 23 يوليو 1952 أو غيرها، أننا أبناء ثقافة لا تجيد قراءة التفاصيل، وتراها بيتا للشياطين، لذا تدمن الكليات واليقينيات، مع ما تحمله من تسطيح للصورة وتغييب لبعض موتيفاتها وتغليب لعناصر منها على حساب عناصر أخرى، ويبدو أنه ليس فينا لبيب يقف على التخوم ليفض الاشتباك ويفصل عناق الكروم واللبلاب، ليس لطمع في تتمييز العناقيد عن الكيزان، فإن احتاجا لتمييز في عينيك فأنت معتل أرمد، ولكن لنفتح طريقا واضحا وممهدا يخرج بنا من السجن الأزلي الذي أدمنّاه وعكفنا على عبادته.
في هذه المناسبة السنوية تتجدد الأسئلة التي أكل الواقع العملي عليها وشرب، ممزوجة بما خالط عقول صائغيها الأوائل من هوى وعداء ومراهقة صنعتها اللحظة وسبكها التورط الآني في قِدر الدراما، هكذا ستفاجأ في 23 يوليو من كل عام بالطنطنة نفسها: انقلاب، ثورة، حكم عسكري، إنهاء للديمقراطية، قضاء على مصر الليبرالية، رحم الله فاروق، لعنة الله على ناصر، ابن الجنايني، بنت البرنس، والقوس مفتوح على قاموس عريض من التعبيرات المؤدلجة والموجهة وغير المخلصة لمنطق أو تاريخ ووقائع.
* هل كانت 23 يوليو 1952 ثورة أم انقلابا؟
الحقيقة أنه يجوز فيها الوجهان، ومن فضلة الوعي والهوى ينطق اللسان بالتصنيف، فلا هي خالصة للثورة بوصفها فعلا شعبيا في مقابلة هيراركي سلطوي “يكون الجيش نفسه جزءا منه”، ولا هي مخلصة للانقلاب العسكري باعتباره خروجا عنيفا يستند إلى القوة في وجه إفراز اجتماعي طبيعي للسلطة السياسية، أو بمعنى آخر، أن تكون مصادرة لاختيارات المجتمع وتفضيلاته وما أسس عليه واقعه السياسي والتنفيذي باتفاق وإقرار عام، وبين هاتين الحقيقتين تحتمل 23 يوليو الوصفين الخلافيين، وفق تفضيلات الواصف ونزوعه السوسيوثقافي ومحفوظاته الدعائية، ولا أداة حقيقية لفض الاشتباك والوقوع على وصف عاقل، إلا بالقراءة السياقية الواسعة للمحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي طرأت الأحداث فيه وعليه ومن عمق بنيته وتعقيداتها.
* هل خروج المؤسسة العسكرية للواقع السياسي العام كله شر؟
الحقيقة في هذه النقطة أن الأمر يحمل تفسيرات وأقاويل أعقد من الإجابات البسيطة المسطحة، كثير من البلدان والحضارات بُنيت على أسس عمادها المؤسسات العسكرية، وكثير من البلدان والمجتمعات هدمتها السطوة العسكرية وسحقتها جنازير الدبابات، نهضة الإغريق والرومان والبابليين والفينيقيين والصينيين والفرس والدولة العربية الملتحفة بالإسلام صنعتها جيوش، وحكام بدرجة مقاتلين وعسكريين، ونكبات أوروبا العصور الوسطى وإسبانيا القرن العشرين وأمريكا اللاتينية ودول وسط وغرب أفريقيا تسببت فيها جيوش وزعامات سياسية عسكرية، وفاصلة القول ليست في شكل علاقات السلطة ونمط ملبس رأسها، وإنما في ديناميكيات العمل السياسي وأطره الواسعة، نهضة فرنسا الحديثة بُنيت على أكتاف العسكريين وفي القلب منهم نابليون، ونهضة مصر الحديثة التي يفخر بها منتقدو 23 يوليو أسسها محمد علي باشا “جد فاروق الذي يبكيه الوطنيون الليبراليون الآن” على قاعدة عسكرية، ومنح نفسه ونجله الأكبر صفة عسكرية، خلطت المدني بالعسكري والسياسي بالسلطوي، وأن نجلس على بُعد 64 سنة من يوليو 52 لنقيم بهذا الاعتباط التسطيحي المسيطر على العقول، فهذه مجانية تحتاج لقدر من المنطق والمعرفة الحقة غير الببغائية.
* هل جنت 23 يوليو 1952 على مصر الليبرالية الديمقراطية؟
ربما يمثل هذا السؤال واحدا من أكثر الأسئلة التباسا في سياق الحديث عن يوليو وأسبابها وآثارها، ونحتاج بداءة لأن نقف على تعريف موضوعي جامع لليبرالية والديمقراطية، وهل كان التعدد الحزبي الذي شهدته مصر في هذا الوقت، بكانتوناته الصغيرة والمتشابهة والملتحقة بإرادات شتى، بين القصر أو الإنجليز أو شركة قناة السويس وغيرها من الشركات الأجنبية الكبرى في مصر، يمثل تعددا حزبيا ومنابر ليبرالية حقيقية، أم كان أقرب إلى توزيع العساكر على رقعة الشطرنج، وقاية للملك وحماية للوزير؟ وهل كانت الانتخابات التي تشهدها مصر، بنسب المشاركة الضئيلة، وإغلاق أبواب الترشح بدرجة كبيرة على الأعيان والإقطاعيين وأبناء الطبقة البرجوازية، باشتراطات التأمين المالي أو امتلاك الأرض أو حتى تدبير قيمة الدعاية الانتخابية في مجتمع يقبع أكثر من 90% من ناسه تحت خط الفقر، انتخابات ديمقراطية حقيقية؟ ناهيك عن نهايتها عند الصندوق المعيب وليس بدايتها منه كما تقتضي الديمقراطية الحقة، مع الصلاحيات الواسعة للملك واستمرائه لحل الحكومة كل عدة أشهر، إلى درجة أن حزب الوفد – الحزب الأكبر والأكثر شعبية – لم يحكم فعليا في خمس وعشرين سنة سابقة على يوليو 52 إلا أقل من تسع سنوات، رغم امتلاكه الأغلبية البرلمانية طوال هذه السنوات تقريبا، ومن ثم فالحديث عن جناية يوليو على ليبرالية مصر وديمقراطيتها قبل حركة الجيش المدعومة شعبيا يحتاج إلى بحث وتمحيص، بغض الطرف عن الغاية العليا للديمقراطية والليبرالية، وللإدارة السياسية أيا كان لونها ومشربها، لسياسة العام الاجتماعي والاقتصادي والإداري لصالح مجموع قوى المجتمع وأفراده، وتوفير فرص حقيقية فيما يخص الحقوق والحريات وفتح أبواب الترقي المعرفي والسياسي والطبقي، وهو ما لم يكن متوفرا في مجتمع النصف بالمائة قبل يوليو 1952، وسواء تحقق بعد حركة الجيش أو ظل غائبا، فإنه لا يعطي أية ميزة لمجتمع ما قبل يوليو على ما أفرزته الحركة من صياغات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فبقاء عيوب الفترة الملكية لا يمكن اعتباره صكًّا نهائيا للحكم وسط إغفال متعمد لتحولات كبرى في مناحٍ أخرى.
* هل أحدثت يوليو 1952 أي تحول إيجابي في بنية المجتمع المصري؟
الناظر الموضوعي ذو الرؤية المتجردة للواقع المصري قبل وبعد يوليو 1952 سيلحظ تحولات كبرى، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ولكنها مثلت خروجا كبيرا ومهما على بنية اجتماعية وسياسية متكلسة، سيطرت على مصر طوال النصف الأول من القرن العشرين، مع قدر ضئيل للغاية من الإزاحة والحراك الطبقي، ولك أن تنظر في الوضع الاقتصادي نموذجا لتلاحظ أن أكبر مبادرة قومية شهدتها مصر قبل يوليو كانت مبادرة حزب الوفد “حزب الأغلبية” لمكافحة الحفاء، أي أن حصة كبيرة من المجتمع كانت وسط نعيم الليبرالية والديمقراطية تسير حافية في شوارع مصر، حصة كبيرة إلى حد تنظيم مبادرة قومية بشأن المشكلة، إضافة إلى نسبة 60% من الشعب يعانون من البلهارسيا، و80% من الأمية، ومجانية نسبية في التعليم قبل الجامعي مقابل تعليم جامعي باهظ الكلفة وغير متاح للمجموع الواسع، وتراكم لثروة مصر الزراعية والعقارية والاقتصادية في أيدي أسر معدودة لقاء ملايين من المزارعين العراة وعبيد الحقل، بينما على جانب يوليو ستجد نموا مضطردا في العدالة الاجتماعية والتنمية وإتاحة خدمات التعليم والصحة لقطاع أوسع، والحقيقة أن هذا جاء على حساب أمور مهمة أبرزها نوعية التعليم التي تدنت نسبيا مع تغليب الكم على الكيف، والاستراتيجية الزراعية التي تراجعت بسبب تفتيت الملكية، ولكن يوليو كانت أبعد نظرا فخرجت من عباءة الرهان الزراعي والريعي إلى اقتصاد الصناعة والقاعدة العصرية للإنتاج، وأحدثت نقلة اقتصادية مدهشة في الخطتين الخمسيتين الأوليين، وجاءت نكسة يونيو لتوقف الخطة الثالثة التي كان منتظرا أن تخرج بمصر من دائرة الدول النامية إلى آفاق العالم المتقدم.
* هل تسببت يوليو في الهزيمة وضياع الأرض؟





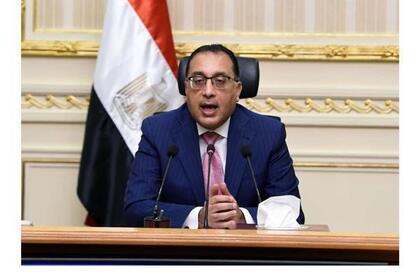



Comments