دور المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا، مُساهمة في الاندماج والتعايش أم تكريس لثنائية الغرب والشرق؟ - ساسة بوست
منذ 12 دقيقة، 21 نوفمبر,2015
تفتح هجمات باريس الأخيرة ملفًا ظنّ العالم أنّه قد أُغلق نسبيًا بعد أكثر من 14 عامًا مرت على هجمات 11 سبتمبر، ويبدو أن هجمات باريس جاءت لتعيد إنتاج سيناريوهات حاولت المجتمعات الغربية تجاوزها بصعوبة شديدة، هذه السيناريوهات تتضافر مع الظروف التي هيّأتها الحرب السورية، وقبلها غزو العراق، وظهور تهديد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وكذا أزمة اللاجئين.
يعيش في أوروبا من المسلمين ما نسبته نحو 6% من إجمالي السكان، نفس النسبة تقريبًا يشترك فيها العديد من الدول الأوروبية، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع اختلاف أصول السكان المسلمين في كل دولة عن أخرى، ويُرجّح أن تزيد هذه النسب بشكل مُطرد خلال السنوات القادمة: زيادة خارجية، عبر الهجرة واللجوء، وداخلية مع زيادة المواليد.
هذه الملايين من المسلمين لا يعيشون الآن بارتياحٍ كاف في المجتمعات الأوروبية، الحقيقة، منذ عقود وهم كذلك، مع الوضع في الاعتبار عوامل تُحفّز من حالة عدم الارتياح المتبادلة، أو قل عدم القدرة على الاندماج بما فيه الكفاية، ما بين الحين والآخر.
وفي الوقت الحالي تُمثّل هجمات باريس العامل الأهم خلال سنوات مضت، فمع الحالة الأمنية “الاستثنائية” التي تشهدها فرنسا الآن، وأوروبا عامة، يُرجح أن يكون العام هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للمسلمين في أوروبا، ورُبما يكون دليل ذلك الاتهامات المُوجّهة للمجتمع المسلم بتهربه من تحمّل مسئولية “الأعمال الإرهابية” وآخرها هجمات باريس.
وإلى حدٍّ كبير، تُمثّل المساجد والمراكز الإسلامية قلب المجتمع المسلم في أوروبا هُناك، وباختلاف مشارب وتوجهات الجهات المسئولة عن تمويل أو إدارة تلك المراكز، تبقى حلقة وصل وبؤر تجمع للمسلمين يراها كثيرٌ من الأوروبيين مُثيرةً للاهتمام.
بداية،ً هل يُعاني المسلمون من الاضطهاد في أوروبا؟
قضيّة شديدة الحساسية بين خطابين يبدوان على خلاف جذري، رغم وجود مُحاولات لتخطي هذا الخلاف في أوروبا، تُسيطر ما بين الحين والآخر نبرة حذرة من الآخر، وما قد يُمثّله من تهديد للمجتمع الأوروبي، الوقت الحالي من الأحيان التي تسيطر فيها هذه النبرة، ورغم احتفاء أوروبا بتاريخها الطويل في تنحية الاعتبار الديني على أي مُستوى، لا تزال النعرات الدينية حكمًا ووجهة تُؤطر الخطاب الثقافي، في أوقات الأزمات بخاصة.
لا يُمكن القول بالجملة إن المسلمين يُعانون من الاضطهاد في أوروبا أو الغرب عمومًا، فالآن ثمّة مسئولون حكوميون من أصول عربية مُسلمة في عدة دول. وإجمالًا يحكم القانون التعامل مع المسلمين وغيرهم، سواءً مواطنين أو مُقيمين، هذا على المُستوى الرسمي الذي يشهد أحيانًا خَرقًا لما يمكن اعتباره قاعدة عامة. أما على المستوى المجتمعي، فبطبيعة الحال، تلعب الظروف المحيطة، فضلًا عن الخطاب الإعلامي، دورًا في تحديد بوصلة التعامل مع المسلمين.
على سبيل المثال، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فإن نسبة التحريض والعمليات العدائية ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت 5 مرات عما كانت عليه قبل أحداث 11 سبتمبر على جانب آخر، شهدت كندا فصلًا آخر من الحكاية على خلفية هجمات باريس، حيث شهدت أول أمس الاثنين 16 نوفمبر) إضرام مجهولين النيران بمسجد السلام: أحد أكبر المراكز الإسلامية في كندا).
بلا شك، يمثل هذا الهجوم خطابًا موجودًا في كندا أكثر عدائية تجاه المسلمين، لكنّ مع الإرادة السياسية – الشعبية التي أطاحت برئيس الوزراء اليميني المتشدد ستيفن هاربر، في مقابل صعود جاستن ترودو، الذي يأتي ببرنامج أكثر تعاونًا وسعيًا نحو اندماج الأقليات في المجتمع الكندي، وعلى رأسها الأقلية المسلمة؛ أسرع المسئولون بمن فيهم رئيس الوزراء، إلى إدانة الحادثة، متوعدين بإلقاء القبض على الفاعلين، ومُؤكدين على أنّ المسلمين جُزء من المجتمع الكندي مُتعدد الأصول.
أما على المستوى المجتمعي، فقد سارعت الكنائس إلى فتح أبوابها أمام المسلمين في مقاطعة أونتاريو، مكان الحادث؛ لأداء الصلوات حتى الانتهاء من ترميم المسجد، الذي تلقى تبرعات، وصلت خلال أقل من يوم إلى 100 ألف دولار، يحتاج المسجد لـ80 ألفًا منها لإعادة الإعمار.
مسجد السلام من الداخل بعد إضرام النيران فيه المصدر: هافينغتون بوست عربي
ويُشار إلى أن ما حدث في كندا يأتي في نفس الوقت الذي يُصر فيه رئيس الوزراء على انسحاب بلاده من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إذ كان ذلك من جُملة وعوده الانتخابية التي تضمنت أيضًا إلغاء كافة القوانين المتعلقة بمنع النقاب أو الحجاب في الأماكن العامة، ويُذكر أنّه في العام الماضي، وعلى نقيض ما حدث أخيرًا، وجّه رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر أصابع الاتهام إلى المنظمات والمراكز الإسلامية في كندا، بدعمها حركاتٍ وصفها بالإرهابية، في حادثة أثارت أزمة كبيرة هُناك.
اقرأ أيضًا : حتى في كندا.. “القبلة إلى اليسار قليلًا” بعد هزيمة اليمين المتشدد
فرنسا تختلف قليلًا عن غيرها، الحديث عن فرنسا والعلاقة بين الأقلية والأكثرية أو الأقلية والنظام، يقتضي النظر بتفحص جاد للسردية التاريخية لبلاد “الحرية والأخوة والمساواة”، فهناك كل ما يخص الاعتقاد والمعتقد يتم التعامل معه بجدية تامة، تقريبًا لا مُهادنة فيها، ويُمكن القول: إنه من هنا اندلعت شرارة الثورة الفرنسية التي دامت سنوات طوال، ومن هُنا أيضًا خاضت فرنسا حربًا شرسًا ضد مظاهر إسلامية اعتبرت أنها تُمثّل تهديدين، واحدٌ للسلم العام، والآخر للهوية الثقافية للبلاد الذي هو أحد جوانب السلم العام، لا في العقل الجمعي الفرنسي وحده، لكن أيضًا لدى قطاع عريض من الأوروبيين عامة.
قبل أيام تداولت بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قالت: إنّه يُظهر اعتداء الشرطة الفرنسية بالقنابل المسيلة للدموع على مُسلمين لحظة خروجهم من المسجد.
ورغم أنّه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو أو توقيت تصويره، إلا أنّ حالات الاعتداء على المسلمين اللاحقة لهجمات باريس متعددة، بشكلٍ ملحوظ يجعل منها ظاهرة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن “قلقه العميق” إزاءها.
ويتجاوز الأمر قلق بان كي مون، إلى قلق حقيقي لدى المسلمين أنفسهم، دفع بعض الأسر إلى إجبار فتياتها على خلع الحجاب، أو عدم التحدث في الأمور الدينية في الأماكن العامة، لقد بات نحو 5 ملايين مُسلم في فرنسا، يشعرون أنّهم جميعًا بمثابة إرهابيين مُحتملين في نظر قانون الطوارئ المفروض، وفي نظر المجتمع.
سيكون من الأفضل أن يُعتقد بالخطأ أنّك يهودي وليس مُسلمًا، لأنه حينئذٍ ستكون المشاكل أقل، طالبة مُسلمة تعيش في باريس
وعلى الرغم من أن الهجمات الأخيرة التي شهدتها باريس لم تُفرق عمليًا بين المسلمين وغيرهم، وعلى الرغم من أنّ 4 من منفذيها هُم مواطنون فرنسيون بحكم الجنسية؛ إلا أنّ مشاعر العداء تجاه المسلمين، لم تستطع أن تتوارى، على الأقل خلف شعار الثورة الفرنسية “الحرية والأخوة والمساواة”، كما لم تستطع أن تفعل قبل ذلك عقب حادثة الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو، في يناير الماضي.
المساجد والمراكز الإسلامية هي بمثابة ملاذ ثقافي واجتماعي بالنسبة للمسلمين في أوروبا، وبالنسبة للسلطات فهي كالوسيط بينها وبين المجتمع المسلم، لذا لم تكن السلطات الأوروبية شديدة التعنت أمام إقامة تلك المراكز والمساجد، وبالطبع لا يُمكن إغفال عاملي الحصر والمراقبة الذين يجعلان منها نقاطًا مثالية لمراقبة العنصر المسلم في المجتمع الأوروبي، فضلًا عن احتوائه أو توجيهه إن لزم الأمر.
بالإضافة إلى هذه النقطة، لا يمكن أيضًا إغفال عاملي المال والسياسة في التأثير على المراكز الإسلامية في أوروبا وتوجهاتها وتحركاتها، ولفترة طويلة كان للملكة العربية السعودية اليد الطولى في إنشاء وإدارة المراكز الإسلامية التي دخل بعضها أعضاء جماعات إسلامية حركية، استطاعوا السيطرة عليها والانطلاق منها؛ لعمل تنظيمي مدني أوسع.
بعد سنوات دخلت تركيا على خط إقامة المراكز الإسلامية ودعم وتمويل المساجد في أوروبا، فيما يعتبره البعض جزء من المخطط الأردوغاني لإعادة الاعتبار لتركيا الإسلامية – العالمية، وقد ساعدها على ذلك انتشار الأتراك في أوروبا من جهة، ومن أُخرى صورة الإسلام المعتدل التي تُحاول الإدارة التركية تصدير نفسها كممثل له؛ الإسلام الذي لا يتعارض كثيرًا مع المبادئ العلمانية في الحكم، بل ربما يعزز من موقف المسار الديمقراطي في دولةٍ مثل تركيا.
ومع مشروع قطر الطموح لتأسيس دور فعّال لها في المنطقة والعالم، والذي بدأ تحديدًا مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم قطر السابق، بدأت قطر في خلق وجود لها في الساحة الإسلامية في أوروبا، بدايةً من تمويل ودعم ترميم وإعادة إعمار الآثار الإسلامية في بعض دول أوروبا الشرقية، نهايةً بإنشاء جُملة من المراكز والمساجد، بينها مساجد تُعد الأولى في بلدان حُرمت الوجود الديني لعقود قبعتها تحت الحكم الشيوعي.
المسجد المركزي في زغرب عاصمة كرواتيا
يُمكن القول إذًا إنّ هذه الدول الثلاث: السعودية وتركيا وقطر) هي القوى المسيطرة بشكلٍ أساسي على المساجد في أوروبا، بالإضافة إلى جماعات وحركات إسلامية استخدمتها لخلق حالة نفوذ اجتماعي وثقافي وسياسي في بعض الأحيان، كجماعة الإخوان المسلمين، والتبليغ والدعوة، وجماعات صوفية، وسلفية. هذه الجماعات إما أنها في هذه الحالة تمثّل ذراعًا أو على الأقل حليفًا لدولة من الدول الثلاث المذكورة، أو غيرها كالإمارات العربية المتحدة التي تدعم تيارًا صوفيًا في أوروبا كما في العالم العربي. أو أنّها تُمثّل نفسها ومشروعها الذي رُبما يكون مُناهضًا لإحدى هذه الدول، كجماعة فتح الله كولن المناهضة لسياسات أردوغان وحزبه الحاكم لتركيا.
مساهمة في الاندماج أم تكريس للغُربة؟
كما يبدو فإن تناول هذا الدور تحديدًا للمساجد، لا يتأتى هو الآخر بالانفصال عن السياقات المحيطة، حتى لا يتم الوقوع في فخ الثنائية، بمعنى أنه لا يمكن إغفال جُملة العوامل سابقة الذكر، كما لا يُمكن إغفال السياقين الاجتماعي والثقافي للمجتمعات التي تتواجد المساجد بينها، فضلًا عن السياسي والخطاب الذي يكرسه لدى هذه المجتمعات.
على سبيل المثال، بادرت أغلب الجمعيات والمراكز الإسلامية في أوروبا بإدانة هجمات باريس فور وقوعها، واصفةً إياها بـ”الأعمال الإرهابية” التي لا تمت للإسلام بصلة. بل إن أئمة مساجد ورموز إسلامية في أوروبا، كانوا قد أصدروا قبل أكثر من عام، فتاوى تُجرّم أفعال تنظيم الدولة الإسلامية، وتُحرّم التعامل أو التعاطف معه، وتُؤكد على ضرورة مُحاربته ومحاربة أفكاره.
مع ذلك كانت من ردود أفعال الحكومة الفرنسية الأولية عقب وقوع الهجمات، إعلان اعتزامها إغلاق المساجد والجمعيات الإسلامية “المتشددة” ولم يكن إعلان الحكومة الفرنسية قد تضمن أي معلومات إحصائية عن هذه المساجد، كما لم يشمل أي تفاصيل عنها، ولم يُجب على سؤال: إذا كان لدى الحكومة الفرنسية علم مسبق بوجود معاقل لنشر ما تسميه بالأفكار المتطرفة التي تهدد السلم العام في المجتمع الفرنسي، فلماذا لم تبادر بإغلاقها سابقًا؟ على ما يبدو إذًا لا يوجد هُناك ما يُدين هذه المساجد والجمعيات قانونيًا، خصوصًا وأن التصريحات الفرنسية الرسمية جاءت بعد موجة مُكثّفة من انتقاد اليمين الفرنسي المتطرف لسياسات الحكومة التي اعتبرها مُتساهلة في مواجهة “نواة الإرهاب” في المجتمع الفرنسي.
هذه الحادثة تكشف عن أمرين: أولهما دور السياسة وحساباتها في تحديد توجهات وتحركات الحكومة الفرنسية، كنموذج في التعامل مع التجمعات الإسلامية وما يُمثلها، فمع الضغط الإعلامي الكبير الذي غالبًا ما يربط بين الممارسات الإرهابية والإسلام كدين ومتدينين، وضغط المعارضة التي تُفضل استخدام أحداث كهذه لإبراز أوجه القصور لدى الحكومة في التعامل مع الأمر؛ تصبح الحكومة مُجبرة على الرضوخ لهذه الضغوط، التي غالبًا أيضًا ما تتقاطع وتوجهات الرأي العام الذي تُساهم في تشكيله بصورةٍ كبيرة.
الأمر الثاني هو وجود بُؤر تشدد بين المجتمع المسلم في أوروبا، تُمثلها مساجد وجمعيات تتبنى خطابًا يرى عدد ليس بقليل أنّه بمثابة التربة الخصبة للنبت الإرهابي أصبح لدى العديد من الكتاب والمفكرين الغربيين تصوّر واضح يكاد يكون لا شية فيه، عن أن المجتمعات الإسلامية في فترات ماضية كانت أكثر تسامحًا من المجتمعات الأوروبية، ما يجعل من الخطاب الإسلامي المتشدد، بتعبيرهم، خطابًا غير أصيل بالنسبة للإسلام والمسلمين.
اقرأ أيضًا: هل كان مسلمو القرون الوسطى أكثر تسامحًا من أوروبيي العصر الحديث؟
“الفكر الوهّابي” هو كلمة السر في هذه الجدلية عند الغرب، بات واضحًا إلى أين تُشار أصابع الاتهام دون الوقوع في فخ التعميم، لذا اندفعت أقلامُ غربية وعربية إلى وصم الوهابية بالدين الرسمي للتنظيمات الإسلامية “المتطرفة”، بداية من القاعدة، وانتهاء بتنظيم الدولة الإسلامية الذي لا تُنكر أدبياته المنشورة عبر وسائل إعلامه الرسمية أنها تستقي بعضا من أفكارها من أفكار محمد بن عبد الوهاب.
كتاب التوحيد وغيره من كتب وأفكار محمد بن عبد الوهاب مُتهمة من قبل الغرب بالمساهمة في التأصيل للتطرف، ولا تقتصر هذه الاتهامات عند الغربيين فقط، لكنّها أيضًا تأتي من مُسلمين من جماعات وتيارات تختلف مع الفكر الوهابي، وما يُمثّله، بل إنّهم قد يرون في الوهابية امتدادًا لخوارج العصور الإسلامية الأولى، وللأفكار الوهابية رواج كبير، عربي أو غربي، مع وجود مساجد وجمعيات تتبناها في أوروبا، تُوجّه اتهامات لدول خليجية بدعمها.

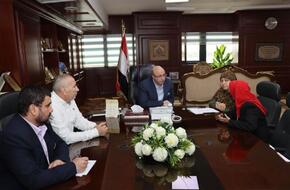







Comments