كمال رمزي يكتب في العيد الـ 100 لميلاد نجيب محفوظ .. نجوم السينما فى سفينة سيد الرواية المصرية (3 – 3)
محمود مرسى، مثل شخصيتين من أبطال روايات نجيب محفوظ: عيسى الدباغ فى «السمان والخريف» لحسام الدين مصطفى 1967، وعمر الحمزاوى فى «الشحات» لحسام الدين مصطفى 1973. وثمة أواصر صلة بين الشخصيتين. كل منهما يقع بين قبضتى اليأس والضياع، وهما من جيل واحد، انغمسا فى العمل السياسى النضالى إن شئت، لفترة ليست قصيرة، فأولهما كان عضوا مهما فى حزب «كلا ثم كلا»، الذى ناصب العداء للملك، ووقف موقفا مبدئيا ضد الاحتلال، وضد النظام، خصوصا حين يكون خارج السلطة.. لكن الفساد لم يغب عن الحزب، ولا عن عيسى الدباغ نفسه، وتأتى ثورة يوليو 1952 لتحل الحزب، مع الأحزاب الأخرى، ويجرى التحقيق مع عيسى الذى يفاجأ بوضعه كرجل بلا حاضر ولا مستقبل، وإن كان عليه أن يعيش.. ومثل الكثير من أبطال نجيب محفوظ المهزومين، يلجأ إلى الإسكندرية.. كذلك الحال، على نحو ما، بالنسبة لعمر الحمزاوى، كان عضوا فى خلية تخطط لاغتيال رجل سياسة أقرب للخونة، وعقب تشتيت الخلية والزج بصديقه «عثمان» ــ أحمد مظهر ــ فى السجن، ينكفئ الشحاذ فى مكتب المحاماة الذى يملكه، لكن يدرك فى لحظة تنوير أنه فقد حياة كان يتمناها، ويغدو نهبا للضيق والاكتئاب والرغبة فى التحرر من قضبان أيامه. ومثل شبيهه «عيسى، يتجه للثغر السكندرى، ينغمس فى علاقات جنسية لا تشفيه.«السمان والخريف» و«الشحات»، يخلوان من الأحداث المحورية، ويتجهان إلى الوقائع الصغيرة، بهدف تلمس أبعاد أزمة بطلين، ويهتمان بالدقائق النفسية أكثر من الحركة الخارجية، وهذا الاتجاه يتطلب ممثلا مرهفا، متفهما، من طراز محمود مرسى، وبرغم المآخذ، وما أكثرها، التى وجهت إلى حسام الدين مصطفى، فإن الجميع أشادوا بأداء الممثل، والواضح أن محمود مرسى قرأ الروايتين قراءة معمقة، وسار فى أدائه على هدى توجيهات نجيب محفوظ ــ إن صح التعبير ــ ولكن بأسلوبه الخاص، المعتمد على ثلاثة محاور: تفهم الانفعالات المركبة تفهما كاملا. الصدق الداخلى، الاقتصاد فى الحركة المادية، باليدين، والسيطرة على ملامح الوجه الذى يكشف باللفتة والشفاه والعيون، عما يجيش فى صدر الشخصية، وعلاقتها بالمكان والبشر.
يكتب نجيب محفوظ: «ما أشد انطواء الإسكندرية على نفسها.. حتى لتبدو مغلقة الأبواب فى وجه الغريب». الغريب هنا، عيسى الدباغ، أو محمود مرسى، الجالس على رمال الشاطئ ليلا. صحيح، البحر أمامه، لكنه يجلس بإهمال وكأنه حبيس زنزانة، ينظر لداخله أكثر مما ينظر إلى الأفق الممتد.. وفى صباح اليوم التالى، يقع بصره على قدمى فتاة الليل التى باتت معه، فيجدهما متسختين، فيفصح وجهه عن اشمئزاز منها، يمتزج بشعور بالهوان، بسبب ما آل له، سياسيا وعاطفيا.
أحيانا، يبدو نجيب محفوظ كما لو أنه مخرج، يشرح لممثله دقائق الموقف، ويوجهه إلى طريقة التعبير، فعندما يضيق بعيسى الدباغ ذرعا بفتاة الليل «ريرى» ــ المتميزة نادية لطفى ــ التى تقيم معه، يعاملها بغلظة، فكيف يكون رد فعلها؟. نجيب محفوظ يشرح ويوجه «عند الإساءة ينقبض وجهها فيلحظ خفية الجهد الذى تبذله لشكم غضبها والتنفيس عن استعدادها العدوانى المكبوت المكتسب من حياة الأرصفة بمعركة باطنية تفتضح آثارها فى خديها وشفتيها وانقلاب سحنتها.. سارت «نادية لطفى» على هدى إرشادات نجيب محفوظ فحققت، عن جدارة، نجاحا مرموقا.
أزمة «عيسى الدباغ» من خارجه، ترجع لقطار الثورة الذى داهمه وتركه وحيدا، أما أزمة «عمر الحمزاوى» فتأتى من داخله، بسبب ذلك الفراغ الذى يحسه برغم ازدحام حياته بأسرة وأصدقاء، لذا فإن محمود مرسى فى «السمان والخريف» يغضب، ويجهش بالبكاء، بينما فى «الشحات» يزداد يأسا وتعاسة، ولعل التنوير المنبعث من صفحات نجيب محفوظ هو الذى أضاء طريقة أداء محمود مرسى، وانتقاله من تدهور أشد وطأة.. فإذا كان نجيب محفوظ يشير، فى البدايات إلى أن بطله يعانى خمولا وضجرا فى عمله وأسرته، فإن الرواية تتابعه وهو يمضى فى ارتياد الملاهى الليلة، متنقلا من امرأة لأخرى، ومع ذلك تزداد غربته عن العالم يوما بعد يوم، وبالتالى ينسحب نفسيا ويغرق داخل ذاته، ويقترب شيئا فشيئا إلى ما يشبه الهذيان والجنون.. محمود مرسى، يجعلنا نتابع، كيفية انسحاب رجل من الحياة.
بعد عقدين من الزمان، عقب «بداية ونهاية»، ويعود فريد شوقى إلى نجيب محفوظ، فى «الشيطان يعظ» 1981، بذات الجوهر ولكن بمظهر جديد، فالبلطجى أصبح فتوة. لم يعد يحمى ويفرض سطوته على بعض نساء حارة الفساد، ولكن غدا مهيمنا على منطقة كاملة. وهو، فى وضعه الجديد، يستخدم النبوت لتأديب من يخرج عن طوعه، بعد أن كان يستخدم رأسه لينطح بها رأس خصمه، فيما يعرف بـ«الروسية»، لذا أطلق عليه، فى «بداية ونهاية» اسم «حسن أبوالروس».
دخل نجيب محفوظ «عالم الفتوات» من بوابة السينما، حين شارك المخرج نيازى مصطفى فى كتابة سيناريو «فتوات الحسينية» 1954. فيما قبل، لم يظهر الفتوات فى روايات نجيب محفوظ، وفيما بعد بدأ تواجد الفتوات فى قصصه القصيرة ليهيمنوا على أعمال كبيرة، مثل «أولاد حارتنا» و«الحرافيش». فالواضح أن كاتبنا الكبير وجد إمكانات واسعة، للتعبير عن عشرات القضايا، من خلال الفتوات، ومعانى أعمق مما جاء فى «فتوات الحسينية» الذى قام ببطولته فريد شوقى أمام غريمه الدائم.. محمود المليجى.
فى حوار مع فريد شوقى قال: «.. عشت فى أحياء شعبية عندما كنت طفلا، شاهدت الفتوات بملابسهم البلدية الأنيقة، ولمست مدى ثقة كل منهم بنفسه وكيف ينازل خصمه ويتعارك حتى الرمق الأخير.. لا شك فى أن هذه المعايشة أمدتنى بعشرات التفاصيل التى أبرزتها فى «فتوات الحسينية» و«الشيطان يعظ» و«فتوات بولاق» على سبيل المثال لا الحصر.. وهنا، فى مجال الفتوات، لابد أن أشير إلى ما أمدتنى به كتابات نجيب محفوظ فى هذا المجال، لا أظن أن كاتبا آخر تبختر الفتوات فى رواياته وتقاتلوا واكتسبوا دلالات عميقة، كما هو الحال عند نجيب محفوظ. إن كتاباته، بالنسبة لى كممثل، من أهم الينابيع التى ارتشفت منها الكثير»(1).
أفلام الفتوات، إجمالا، تتضمن أحداثا وشخصيات تشد انتباه المشاهدين، فهنا، تندلع الخصومات، وتتصاعد التناقضات، وتتوالى المواجهات، حاملة معها معظم ألوان الصراعات، المعنوية والمادية، وثمة معركة تصفية الحساب الأخيرة، الدامية غالبا.. لكن، لا يمكن تجاهل أن هذه الأفلام، تلبى حاجة عند الجمهور، أشمل وأهم من مجرد كونها تنتمى إلى «سينما العنف»، أو «سينما المغامرات»، ذلك أنها، فى بعد من أبعادها، تعبر عن حلم العدالة، فالفتوة عادة، هو رمز الطغيان، سلطة القمع، قوة الظلم والظلام. وفى المقابل، أناس يعملون وينتجون، يذهب عرقهم لحملة النبابيت، وكلما انهار فتوة، يحل مكانه فتوة آخر، ينعش الآمال قليلا، لكن سرعان ما تصبح سلطته المطلقة، هى الفساد المطلق، ويتحول إلى غول لا يرحم.
بعد فريد شوقى، توالى ظهور الفتوات، بأداء موفق من صلاح قابيل فى «شهد الملكة» لحسام الدين مصطفى 1985، حيث يطالعنا بعين مفقوءة، بينما العين الأخرى، تفيض بنوع صامت من الغدر.. ثم مجدى وهبة، فى «المطارد» لسمير سيف 1985، الذى لا يعرف الرحمة، والذى لا يتوقف عن فرض المزيد من الإتاوات.. وفى «التوت والنبوت» لنيازى مصطفى 1986، نشهد حمدى غيث، وهو يذل من يخرج عن طاعته، فيجبر الأم أمينة رزق، على صفع ابنها عزت العلايلى، على مرأى من أهالى الحارة. وهكذا، حسب وصف نجيب محفوظ للفتوات بأنهم «يتبخترون فوق صدرونا»، بما فى ذلك محمود عبدالعزيز، الذى أعلن، وربما صادقا، فى «الجوع» أنه لن يظلم أحدا، ولكن مع استمرار الحياة الناعمة، والسلطة، يصبح شرها، شريرا، مستبدا.. إنها مجموعة من أفلام تعد احتجاجا متواليا من أجل العدل.
المساحة الزمنية التى تعرضت لها روايات نجيب محفوظ طويلة، ومنذ أكثر من نصف قرن اتجهت السينما المصرية إلى تلك الأعمال، وتلقف كل جيل من أجيال المخرجين المتعاقبة الروايات التى تتعرض لفترات عاشوها، أو كانوا قريبين منها: صلاح أبوسيف اختار «القاهرة 30» و«بداية ونهاية» اللتين تدور أحداثهما فى الأربعينيات. عاطف سالم فضل «خان الخليلى» التى تدور فى دوامة الحرب العالمية الثانية. حسن الإمام حقق «الثلاثية» التى تمتد من سنوات ما قبل ثورة 1919 إلى مشارف الخمسينيات.. أما الجيل التالى من المخرجين، فإنه تعرض إلى ما يتوافق معه. حسام الدين مصطفى قدم «السمان والخريف» التى تتعرض إلى ما جرى عقب ثورة 1952، وكانت «الحب تحت المطر» التى تعبر عن الندوب الروحية التى أصابت أبطالها بسبب هزيمة 1967 من نصيب حسين كمال الذى قدم أيضا «ثرثرة فوق النيل» التى ترصد أجواء الإلهاء والطمأنينة الكاذبة التى أدت للنكسة.. ثم يأتى جيل لاحق، من مخرجيه على بدرخان، ليراجع، على نحو نقدى، ممارسات مخالب السلطة ضد أبناء الثورة فى «الكرنك»، ويفضح قيم الانفتاح المنحطة فى «أهل القمة». وتتوالى الأجيال لينظر عاطف الطيب، بغضب، إلى واقع الثمانينيات خلال «الحب فوق هضبة الهرم» 1986.
وجد كل جيل ضالته فى منجم نجيب محفوظ، ليس بالنسبة للمخرجين فحسب، بل للممثلين فى المحل الأول، وفى أكثر من لقاء، صرح نجيب محفوظ «بأن الممثل، هو أفضل عنصر فى السينما المصرية»، ولنا أن نضيف: خصوصا فى الأفلام التى تعتمد على رواياته، والتى جسدتها أجيال متعددة من الممثلين. الآباء والأمهات، عبدالوارث عسر فى «خان الخليلى» وأمينة رزق فى «بداية ونهاية»، والملاحظ أن الأمهات أوسع انتشارا من الآباء، باستثناء الحضور الطاغى ليحيى شاهين فى الثلاثية، ربما لأن والد نجيب محفوظ رحل مبكرا.. طابور الأمهات يضم آمال زايد فى «بين القصرين» و«قصر الشوق» و«خان الخليلى»، وعقيلة راتب فى «السراب» لأنور الشناوى 1970، وتحية كاريوكا فى «الطريق» و«الكرنك». وهذا على سبيل المثال لا الحصر.. أما الجيل التالى فإنه يشمل فيما يشمل عماد حمدى، رشدى أباظة، فريد شوقى، عمر الشريف، شادية، سميرة أحمد.. ثم لحق بهم حسن يوسف، صلاح قابيل، ماجدة الخطيب، سعاد حسنى، سهير رمزى.. وهكذا، حتى نصل إلى أحمد زكى وآثار الحكيم فى «الحب فوق هضبة الهرم»، والفيلم من واقعيات عاطف الطيب النضرة. كتب قصته نجيب على طريقة المعالجات السينمائية، وتجدها فى العديد من رواياته المتوسطة الطول أو القصيرة، حيث عدم الالتزام بالبناء الصارم، واللجوء إلى التقرير بدلا من التجسيد، والتعليق على المواقف، والتعبير عن الفكرة بعبارات مباشرة، تأتى على لسان المؤلف أو من خلال إحدى الشخصيات، وهذه الكتابات وإن كانت تزعج، أو على الأقل لا ترضى، نقاد الأدب، إلا أن كتّاب السيناريو يتلقفونها كمادة بالغة الثراء، لصياغة فيلم مكتمل، على الورق.
كاتب السيناريو، مصطفى محرم، ترجم بالصورة، عبارات نجيب محفوظ، ترجمة موفقة، أزاد ألقها أحمد زكى وآثار الحكيم، بقيادة عاطف الطيب طبعا.. القصة تروى من خلال البطل وتبدأ بالجمل التالية «أريد امرأة. أية امرأة.. إنها صرخة مدوية. انبعثت أول ما انبعثت من جوانحى على هيئة هسمات من الذهول. همسات من الأنين. همسات من الغضب».. هذه الحالة، يحولها الفيلم، قبل ظهور العناوين، إلى لقطات لـ«على» أو «أحمد زكى»، يسير فى شوارع المدينة المزدحمة بالناس والعربات، سيارة فخمة تقودها امرأة جميلة تقف بجانبه. المرأة تدعوه بإيماءة فيلبى النداء فورا. المرأة تنطلق بعربتها إلى الخلاء. تنقض عليه مقبلة حاضنة.. يسمع صوت والدته التى توقظه من النوم. وجه أحمد زكى المتفصد عرقا يعبر عن الضيق وبقايا نشوة الحلم والإحباط. إنه أستاذ الانفعالات المركبة.. الفيلم، كما القصة، يتلمس، بفهم، أزمة جيل الثمانينيات، فى العمل والسكن والمستوى الاقتصادى والحياة.. وفى نوبة من نوبات التحدى والجنون، يتفق الحبيبان «أحمد زكى» و«آثار الحكيم» على الزواج سرا، من دون مشقة أو معرفة أسرتيهما. يذهبان إلى فندق، أو قل «لوكاندة» متواضعة الحال، مريبة، للاختلاء ببعضهما بعضا.. وفى موقف تؤديه آثار الحكيم ببراعة، تلسعها نظرات موظف الاستقبال، وتنتابها حالة من الرفض النفسى للمكان، خصوصا حين ترى مشبوهات يسرن فى الطرقة مع طلاب متعة. تتجمد تماما ولا يبقى أمام زوجها، أحمد زكى، إلا الاستجابة لنفورها الكامل. يخرجان معا، وقد داهمهما ما يشبه الهزيمة التى تتجلى فى أقصى صورها، حين يُزَجُّ بهما فى صندوق عربة شرطة، لارتكاباتهما فعلا فاضحا، فوق هضبة الهرم.. وها هما، ينظران، بيأس وغضب وانكسار، من شبكة شباك عربة الشرطة، إلى شوارع المدينة المزدحمة.
على خارطة شخصيات نجيب محفوظ، ستجد المرأة القوية، جالبة الضياع والموت لكل من رغبها واقترب منها، مجسدة فى «نادية الجندى» حين قدمت «زهيرة» فى «شهد الملكة» لحسام الدين مصطفى 1985.. كما سترى معنى الإجحاف فى وجه «نبيلة عبيد» حين اغتصبها الفتوة الطاغية «عادل أدهم» فى «الشيطان يعظ» أمام زوجها نور الشريف.
نور الشريف، صاحب الحظ الأوفر فى منجم نجيب محفوظ. دخل عالم الروائى الكبير من بوابة «قصر الشوق» عندما أسند له حسن الإمام دور «كمال عبدالجواد»، وهو أول دور له على شاشة السينما.. وبعد أحد عشر عاما، يمثل ذات الشخصية فى «السكرية» لحسن الإمام، حيث أصبح كمال عبدالجواد فى خريف العمر، بعد أن تلاشت آماله، وفشل حبه، ولم يتزوج أو يحقق نجاحا يذكر.. وللحظة، يخفق قلبه بحب شابة صغيرة تشبه «عايدة»، حبيبة الأيام الخوالى، ويدرك أنها علاقة لا يمكن أن تنمو أو تستمر.. وها هو يتأملها، أمام زجاج محل الملابس، فتتجلى فى عينيه نظرة كابية، تحمل معانى احتضار الأمانى، وإدراك قسوة مرور الزمن، ورثاء الذات.. إنه، فى هذه اللقطة، يختزل، ويعبر عن صحفات من الكتاب.
نور الشريف، من أكثر، وأفضل الممثلين الذى جسدوا المهزومين والخاسرين عند نجيب محفوظ: إنه «كامل لاظ رؤوبة»، المتلاشى فى قوة شخصية والدته، المنطوى على نفسه، الفاشل فى تعليمه وعمله وزواجه، بطل «السراب» لأنور الشناوى.. وهو الذى سرق رواتب الموظفين من أجل حبيبته «معالى زايد»، كى يقضى معها أياما جميلة على شاطئ بعيد، ويكتشف أنها مخادعة، خائنة، وتبدأ رحلة جنونه حين يُقبض عليه... ويصل إلى مستوى رفيع من القدرة على الإقناع، فى موقف اغتصاب زوجته، أمامه، فتنطق رقبته، وملامح وجهه، بعروقه النافرة، وعيونه الجاحظة، بكل ما فى «الشيطان يعظ» من مقت للفتوات، وكراهية لظلم الطغاة، ورغبة فى الثأر، وإحساس مر بالعجز... إنه أحد نجوم السينما المصرية ــ وما أكثرهم ــ الذين لمعوا، فى سفينة نجيب محفوظ.

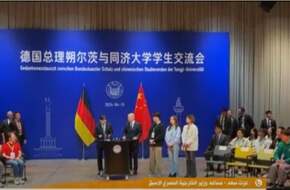







Comments