الفقه في مراتب الأحكام وأدب الخلاف
من الفقه الذي يغفل عنه بعض المتدينين: معرفة مراتب الأحكام الشرعية، وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها، وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها. فهناك الأحكام الظنية التي هي مجال الاجتهاد، وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، سواء كانت أحكاماً فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني الثبوت، أو ظني الدلالة، أو ظنيهما معاً، وهذا شأن معظم الأحكام المتعلقة بالعمل، كأحكام الفقه، فهذه يكفي فيها الظن، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة، التي لا يغني فيها إلاّ القطع واليقين. والاختلاف في الأحكام الفرعية العملية والظنية، لا ضرر فيه ولا خطر منه، إذا كان مبنياً على اجتهاد شرعي صحيح، وهو رحمة بالأمة، ومرونة في الشريعة، وسعة في الفقه، وقد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فما ضرهم ذلك شيئاً، وما نال من أخوتهم ووحدتهم كثيراً ولا قليلاً. وهناك الأحكام التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ووصلت إلى درجة القطع، وإن لم تصبح من ضروريات الدين، فهذه تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة، ومن خالفها خالف السنة، ووصف بالفسق والبدعة، وقد ينتهي به الأمر إلى درجة الكفر. وهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث يستوي في العلم بها الخاص والعام، وهي التي يكفر من أنكرها بغير خلاف، لما في إنكارها من تكذيب صريح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز إذن أن توضع الأحكام كلها في إطار واحد، ودرجة واحدة، حتى يسارع بعض النّاس إلى إلصاق الكفر أو الفسوق أو البدعة بكل من عارض حكماً ما، لمجرد اشتهاره بين طلبة العلم، أو تداوله في الكتب، دون تمييز بين الأصول والفروع، ولا تفريق بين الثابت بالنص، والثابت بالاجتهاد، وبين القطعي والظني في النصوص، وبين الضروري وغير الضروري في الدين، فلكل منها منزلته، وله حكمه. إن فقهاءنا الكبار قد اختلفوا أحياناً في بعض المسائل اختلافاً قد يتجاوز الآحاد إلى العشرات من الأقوال، وقد تجد في المسألة الواحدة كل الأقوال التي تقتضيها القسمة العقلية، كأقوالهم فيمن قتل مسلماً معصوم الدم تحت تأثير الإكراه: هل يجب القصاص على المكره الذي باشر القتل؟ أم على المكره الذي أجبره وهدده، لأن المتسبب القاتل لم يكن إلاّ مجرد آلة له؟ أم عليهما معاً .. هذا بمباشرته وذلك بإكراهه وإجباره؟ أم ليس على واحد منهما القصاص، لأن جريمة القتل لم تكتمل لدى كل منهما؟ بكل هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء، ولكل وجهته وتعليله. بل في داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبوعة نجد العديد من الأقوال، أو الروايات، أو الوجوه، أو الطرق، واختلاف التصحيحات والترجيحات فيما بينها لدى علماء المذهب. وبحسبي هنا أن أذكر أن الخلاف في مذهب مثل مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب يقوم على اتباع الأثر، قد اتسع للعديد من الروايات والأقوال بحيث ملأت كتاباً من اثني عشر مجلداً هو كتاب الإنصاف في الراجح من الخلاف . لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب على شبابنا أن يحسنوا التفقه فيها: أن يعرفوا ما يجوز فيه الخلاف، وما لا يجوز، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز، وأهم من هذا كله أن يتعلموا أدب الخلاف وهو أدب ورثناه من أئمتنا وعلمائنا الأعلام، علينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين. كيف تختلف آراؤنا، ولا تختلف قلوبنا؟ كيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته، أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفته.. ودون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو دينه؟ يجب أن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع، ما له من دافع، وأن لله حكمة بالغة حين جعل من أحكام الشريعة القطعي في ثبوته ودلالته، فلا مجال للخلاف فيه، وهذا هو القليل، بل الأقل من القليل، وجعل منها الظني في ثبوته أو دلالته، أو فيهما معاً، فهذا بما فيه مجال رحب للاختلاف، وهو جلّ أحكام الشريعة، وهناك من العلماء من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها، دون تعصب لمذهب أو قول، مثل الأئمة: ابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر العسقلاني، والدهلوي، والشوكاني، والصنعاني.. وغيرهم، ولكن محاولات هؤلاء من قبل، لم ترفع الخلاف، ومحاولات غيرهم من بعد، لم ترفع الخلاف ولن ترفعه. ذلك، لأن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر، وطبيعة الحياة، وطبيعة اللغة، وطبيعة التكليف، فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية، فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها. على أن الخلاف العلمي في ذاته لا خطر فيه، إذا اقترن بالتسامح وسعة الأفق، وتحرر من التعصب والاتهام وضيق النظر.وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في كثير من المسائل الفرعية، أو الأحكام العملية، فوسع بعضهم بعضاً، ولم يعب بعضهم على بعض. وجاء تلاميذهم من التابعين لهم بإحسان، فوجدوا في هذا الخلاف سعة ورحمة للأمة، وخصوبة وثراء للفقه، ولم تضق بذلك صدورهم، كما فعل أناس من المتأخرين بعد، يقول خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، اختلافهم رحمة. وكيف لا يختلف الصحابة ومن بعدهم، وقد اختلفوا في حياة الرسول نفسه، وأقر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف، دون أن يلوم أحداً من المختلفين. وهذا ثابت في قضية صلاة العصر في بني قريظة، حين قال لهم بعد غزوة الأحزاب: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وصلى بعضهم في الطريق قبل فوات الوقت، وقالوا: إنما أراد منا سرعة النهوض لا تأخير الصلاة عن وقتها، وأبي الآخرون إلاّ أن يقفوا عند ظاهر النص، وأن ينفذوه بحرفيته.. أخذ الأولون بالفحوى، وأخذ الآخرون بالظاهر، فأولئك ـ كما قال ابن القيم ـ سلف أهل القياس والمعاني، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغه صنيع الفريقين، لم يلم هؤلاء ولا هؤلاء، مع أن أحدهما مخطئ بلا ريب، فدلّنا ذلك على أن العمل إذا تم بناء على اجتهاد، فلا ينبغي أن يكفر أو يؤثم. وقد عرفنا في عصرنا أناساً يجهدون أنفسهم، ويجهدون الناس معهم، ظانين أنهم قادرون على أن يصبوا النّاس في قالب واحد يصنعونه هم لهم، وأن يجتمع النّاس على رأي واحد، يمشون فيه وراءهم، وفق ما فهموه من النصوص الشرعية، وبذلك تنقرض المذاهب، ويرتفع الخلاف، ويلتقي الجميع على كلمة سواء. ونسي هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي يحتمل الخطأ، كما يحتمل الصواب، إذ لم تضمن العصمة لعالم فيما ذهب إليه، وإن جمع شروط الاجتهاد كلها. كل ما ضمن له هو الأجر على اجتهاده، أصاب أم أخطأ. ولهذا لم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى المذاهب المدونة مذهباً جديداً!ومن الغريب أن هؤلاء ينكرون على أتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها، على حين يطلبون من جماهير النّاس أن يقلدوهم ويتبعوهم. ولا تحسبن أني أنكر عليهم دعوتهم إلى اتباع النصوص، أو اجتهادهم في فهمها، فهذا من حق كل مسلم استوفى شرائط الاجتهاد وأدواته، ولا يملك أحد أن يغلق باباً فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، إنما أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء الأمة، واحتقارهم للفقه الموروث، ودعاواهم العريضة في أنهم وحدهم على الحق، وما عداهم على خطأ أو ضلال، وتوهمهم أن باستطاعتهم إزالة الخلاف، وجمع النّاس قاطبة على قول واحد، هو قولهم. قال لي واحد من طلبة العلم المخلصين من تلاميذ هذه المدرسة مدرسة الرأي الواحد : ولم لا يلتقي الجميع على الرأي الذي معه النص؟قلت: لا بد أن يكون النص صحيحاً مسلماً به عند الجميع، ولا بد أن يكون صريح الدلالة على المعنى المراد، ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية، فقد يكون النص صحيحاً عند إمام ضعيفاً عند غيره، وقد يصح عنده ولكن لا يسلم بدلالته على المراد، فقد يكون عند هذا عاماً وعند غيره خاصاً، وقد يكون عند إمام مطلقاً، وعند آخر مقيداً، وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو الحرمة، ويراه ذلك دالاً على الاستحباب أو الكراهية وقد يعتبره بعضهم محكماً، ويراه غيره منسوخاً.. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ، وفي رسالة الإنصاف في أسباب الاختلاف وفصّلها العلامة الشيخ على الخفيف في كتاب أسباب اختلاف الفقهاء .. خذ مثلاً هذه الأحاديث:1- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النّار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خُرصاً (أي :قرطا ً) من ذهب، جعل في أذنها مثله يوم القيامة (رواه أبو داود والنسائي ). 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار، فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار، فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها (رواه أبو داود ). 3- ومثل ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على فاطمة رضي الله عنها سلسلة من ذهب كانت تتحلى بها، فباعتها واشترت بثمنها عبداً فأعتقته، فحدّث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار (رواه النسائي ). هذه الأحاديث كان للعلماء منها مواقف مختلفة.1- منهم من نظر في سندها فوجد فيها من أسباب الضعف ما جعله يردها، ويحكم عليها بالضعف، ولا سيما أن الحكم بالتحريم يقتضي التثبت والتحري، وخصوصاً في أمر اشتهر القول بحله والعمل عليه، ويكاد يمس كل بيت مسلم. 2- ومن العلماء من صححها، ولكنه ذهب إلى أنها منسوخة، فإنه قد ثبت إباحة تحلي الذهب للنساء بأدلة أخرى، ونقل البيهقي وغيره الإجماع على ذلك، واستقر عليه الفقه والعمل. 3- ومنهم من خصصها بأن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أدّاها، ويستدل لذلك بأحاديث لم تسلم من النقد أيضاً، والخلاف في زكاة الحلي للنساء بين المذاهب أمر معروف. 4- ومنهم من أوّلها بأن الوعيد إنما هو في حق من تزينت به وأظهرته، أي: أن الوعيد فيها على الاختيال لا على مجرد الزينة، وقد ذكر النسائي بعض هذه الأحاديث تحت عنوان: باب الكراهية للنساء في إظهار حلي الذهب . وقال بعضهم: إن الإنكار إنما كان على ما فيه غلظ وضخامة من الحلي فإنه مظنة الفخر والخيلاء. 5- وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني في عصرنا مذهباً جديداً في هذه الأحاديث، فحكم بصحتها، ورآها نصاً محكماً في تحريم الذهب المحلق على النساء، مخالفاً بذلك ما نقل من الإجماع على إباحته، وما استقر عليه الفقه في جميع المذاهب، وما مضى عليه عمل الأمة طوال أربعة عشر قرناً. فليت شعري هل منع وجود هذه الأحاديث من الخلاف في ثبوتها ودلالتها؟ وهل تستطيع المدرسة الأثرية الحديثة أن ترفع الخلاف، أو تجمع النّاس على قول واحد، ما دام معها حديث أو أثر تحتج به؟ الجواب واضح، وسيظل النّاس يختلفون في مثل هذه الأمور، ولا حرج في ذلك ولا ضير إن شاء الله ((ولكلِّ وجهةُ هُو مولِّيها )).ولم أجد في دعاة الإسلام ومصلحيه في هذا العصر من فهم قضية الخلاف وأدبه وفقهه كما فهمها الإمام حسن البنا، وربى عليها أبناء مدرسته. فرغم حرصه أشد الحرص على وحدة الصف الإسلامي، ومحاولاته الجادة والواعية لتوحيد كلمة الجمعيات والهيئات الإسلامية، وجمعها على الحد الأدنى من الأصول والمفاهيم الإسلامية، وفي ذلك وضع أصوله العشرين المعروفة، رغم ذلك كان يؤمن بأن الخلاف في فروع الدين وأحكامه العملية الجزئية، لا مفر منه، ولا يمكن تجنبه، وقد عرض لذلك في أكثر من رسالة من رسائل دعوته، فأجاد وأفاد. في رسالته التي عنوانها دعوتنا يتحدث عن خصائص دعوته بأنها دعوة عامة، لا تنسب إلى طائفة خاصة، ولا تنحاز إلى رأي عرف عند النّاس بلون خاص، وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه، وتود أن تتوحد وجهة الأنظار والهمم، حتى يكون العمل أجدى، والانتاج أعظم وأكبر، وهي مع الحق أينما كان، تحب الإجماع وتكره الشذوذ، وإن أعظم ما ابتلي به المسلمون الفرقة والخلاف، وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به أولها. ومع هذا الإيمان بضرورة الوحدة وكراهية الفرقة، يقول الشيخ رحمه الله: ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة، ولا يمكن أن تتحد في هذه الفروع -الآراء والمذاهب - لأسباب عدة منها:اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه، وإدراك الدلائل، والجهل بها، والغوص على أعماق المعاني، وارتباط الحقائق بعضها ببعض، والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها، والنّاس في ذلك جد متفاوتين، فلابد من خلاف.ومنها سعة العلم وضيقه، وأن هذا بلغه ما لم يبلغ ذلك، والآخر شأنه كذلك، وقد قال الإمام مالك لأبي جعفر: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وعند كل قوم علم، فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة. ومنها : اختلاف البيئات، حتى إن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة، وإنك لترى الإمام الشافعي رضي الله عنه يفتي بالقديم في العراق، ويفتي بالجديد في مصر، وهو في كليهما آخذ بما استبان له، وما اتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما. ومنها: اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقي لها، فبينا نجد هذا الراوي ثقة عند هذا الإمام تطمئن إليه نفسه، وتطيب بالأخذ منه، تراه مجروحاً عند غيره لما علم عن حاله. ومنها: اختلاف تقدير الدلالات، فهذا يعتبر عمل الناس مقدماً على خبر الآحاد مثلاً، وذاك لا يقول معه به .. وهكذا.كل هذه أسباب جعلتنا نعتقد أن الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل، بل هو يتنافى مع طبيعة الدين، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور ويماشي الأزمان، وهو لهذا سهل مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد. نعتقد هذا فنلتمس العذر كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات، ونرى أن هذا الخلاف لا يكون أبداً حائلاً دون ارتباط القلوب، وتبادل الحب، والتعاون على الخير، وأن يشملنا وإياهم معنى الإسلام السابغ بأفضل حدوده، وأوسع مشتملاته، ألسنا مسلمين وهم كذلك؟وألسنا نحب أن ننزل على حكم اطمئنان نفوسنا وهم يحبون ذلك؟ وألسنا مطالبين بأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا؟ ففيم الخلاف إذن؟ ولماذا لا يكون رأينا مجالاً للنظر عندهم كرأيهم عندنا؟ ولماذا لا نتفاهم في جو الصفاء والحب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفاهم؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف بعضهم بعضاً في الافتاء، فهل أوقع ذلك اختلافاً بينهم في القلوب؟ وهل فرق وحدتهم أو مزق رابطتهم؟ اللهم لا، وما حديث صلاة العصر في بني قريظة ببعيد. وإذا كان هؤلاء قد اختلفوا، وهم أقرب النّاس عهداً بالنبوة، وأعرفهم بقرائن الأحكام، فما بالنا نتناحر في خلافات تافهة لا خطر لها؟ وإذا كان الأئمة، وهم أعلم النّاس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، قد اختلف بعضهم على بعض، وناظر بعضهم بعضاً، فلم لا يسعنا ما وسعهم؟ وإذا كان الخلاف قد وقع في أشهر المسائل الفرعية وأوضحها، كالأذان الذي ينادى به خمس مرات في اليوم الواحد، ووردت به النصوص والآثار، فما بالك في دقائق المسائل التي مرجعها إلى الرأي والاستنباط؟ وثم أمر آخر جدير بالنظر، إن النّاس كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى الخليفة فيقضي بينهم، ويرفع حكمه الخلاف، أما الآن فأين الخليفة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأولى بالمسلمين أن يبحثوا عن القاضي، ثم يعرضوا قضيتهم عليه، فإن اختلافهم من غير مرجع لا يردهم إلاّ إلى خلاف آخر. يعلم إخواننا كل هذه الحيثيات، فهم لهذا أوسع النّاس صدوراً مع مخالفيهم، ويرون أن مع كل قوم علماً، وفي كل دعوة حقاً وباطلاً، فهم يتحرون الحق ويأخذون به ويحاولون في هوادة ورفق إقناع المخالفين بوجهة نظرهم، فإن اقتنعوا فذاك، وإن لم يقتنعوا فإخوان في الدين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا هو رأي الأستاذ البنا في الخلاف الفقهي وموقفه منه، وهو يدل على عمق فهمه للدين، وللتاريخ، وللواقع جميعاً. ومن المواقف العملية التي تروى عنه -وربما رويت عن علماء آخرين أيضاً - مما له دلالة بليغة في موضوعنا: أنه ذهب لزيارة إحدى القرى لإلقاء محاضرة هناك، وكان ذلك في رمضان، وقد انقسم أهل القرية إلى فريقين يختصمان حول صلاة التراويح، أهي عشرون ركعة كما صليت في عهد عمر، وتوارثها النّاس على مر القرون بعد ذلك، أم هي ثماني ركعات فقط، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يزيد على ذلك في رمضان ولا غيره؟ رأيان تعصب لكل منهما فريق من أهل البلدة حتى كادا يقتتلان وكل يدعي أنه على الحق والسنة، وأن الآخر على خطأ وبدعة، فلما عرفوا أن الشيخ المرشد البنا قادم إليهم، رضوا أن يحتكموا إليه فيما اختلفوا فيه، وكل فئة تحسب أنه سيحكم لها ضد الأخرى.ولكن الأستاذ الإمام رحمه الله اتجه يهم وجهة أخرى.قال: ما حكم صلاة التراويح؟قالوا: سنة، يثاب من فعلها، ولا يعاقب من تركها.قال: وما حكم الأخوة بين المسلمين؟قالوا: فريضة دينية، ودعامة من دعائم الإيمان.قال: وهل يجوز في شرع الله أن نضيع فريضة للمحافظة على سنة؟إنكم لو أبقيتم على أخوتكم ووحدتكم، وانصرفتم إلى بيوتكم، ليصلي كل منكم في بيته ما ترجح له واطمأن إلى دليله : ثماني ركعات أو عشرين لكان خيراً من أن تحتصموا وتقتتلوا.ذكرت ذلك لبعض النّاس، فقال: هذا فرار من قول الحق، وبيان السنة من البدعة، وهذا واجب.قلت : هذا أمر فيه سعة، وأنا ـ وإن كنت أصلي ثماني ـ لا أبدّع من صلى عشرين.قال: ولكن الفصل في الخلف واجب لا يجوز الهرب منه.قلت: هذا صحيح حين يدور الأمر بين حلال وحرام، أو بين حق وباطل، أما الأمور التي اختلفت فيها المدارس الفقهية.. وغدا لكل منها فيها وجهة، ودار الأمر فيها عادة بين الجائز والأفضل، فلا داعي للتشدد والتعنت فيها.وهذا ما قرره العلماء المنصفون في وضوح وجلاء: قال في شرح غاية المنتهى ، من كتب الحنابلة:من أنكر شيئاٍ من مسائل الاجتهاد، فلجهله بمقام المجتهدين، وعدم علمه بأنهم أسهروا أجفانهم، وبذلوا جهدهم، ونفائس أوقاتهم في طلب الحق، وهم مأجورون لا محالة أخطأوا أو أصابوا، ومتبعهم ناج، لأن الله شرع لكل منهم ما أداه إليه اجتهاده، وجعله شرعاً مقراً في نفس الأمر، كما جعل الحل في الميتة للمضطر، وتحريمها على المختار، حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين بالإجماع، فأي شيء غلب على ظن المجتهد، فهو حكم الله في حقه وحق من قلده . ونقل ابن تيمية في الفتاوى المصرية قوله:مراعاة الائتلاف هي الحق، فيجهر بالبسملة أحياناً لمصلحة راجحة، ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت من خشية تنفيرهم، نص الأئمة، كأحمد على ذلك في البسملة، ووصل الوتر وغيره، مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز ، مراعاة للائتلاف أو لتعريف السنة، أو أمثال ذلك، والله أعلم . ويشير بترك بناء البيت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعائشة: لولا قومك حديثو عهد بجاهلية، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم (رواه البخاري ). وهذا العلامة ابن القيم يتحدث في زاد المعاد عن القنوت في صلاة الصبح، بين من أنكره مطلقاً، في النوازل وغيرها، واعتبره بدعة، وبين من استحبه مطلقاً في النوازل وغيرها، ويرجح أن هديه صلى الله عليه وسلم هو القنوت عند النوازل، كما دلت عليه الأحاديث، وأن هذا ما أخذ به فقهاء الحديث، فهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتركون حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله سنة، وتركه سنة: مع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفاً للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل.. إلخ، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. قال: وركن الاعتدال (أي: من الركوع )، محل للدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت ثناء ودعاء فهو أولى بهذا المحل، وإذا جهر به الإمام أحياناً ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك.فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عبّاس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة، ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين. وهذا من الاختلاف المباح، الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك (يعني الحج ) من الإفراد والقران والتمتع. وليس مقصدنا إلاّ ذكر هديه صلى الله عليه وسلم فإنه قبلة القصد، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مقدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز، ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله، فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله (1/144 ). وأكثر من ذلك أن للمأموم أن يصلي وراء إمامه، وإن رآه يفعل ما ينقض الوضوء، أو يبطل الصلاة في نظره هو، أي : المأموم، ما دام هذا سائغاً في مذهب الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسلمون متفقون على جواز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ بالبسملة، ومنهم من لا يقرأ بها، ومع هذا، كان بعضهم يصلي خلف بعض، مثلما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سراً ولا جهرا ً. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم، وأفتاه مالك: لا يتوضأ، فصلّى خلفه أبو يوسف ولم يعد .وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، أصلي خلفه؟ فقال: كيف لا تصلي خلف سعيد ابن المسيب ومالك؟ قال: وفي هذه المسألة صورتان :إحداهما: ألاّ يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل صلاته، فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم. الثانية: تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، مثل أن يمس ذكره، أو النساء لشهوة، أو يحتجم أو يفصد، أو يتقيأ، ثم يصلي بلا وضوء ـ فهذه فيها نزاع مشهور، وصحة صلاة المأموم هو قول جمهور السلف، وهو مذهب مالك، وهو قول آخر في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب. (الفواكه العديدة: 2/181 وانظر كتابنا فتاوى معاصرة ص 201 - 204ط ثانية ).


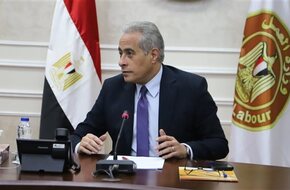






Comments