دكتور حازم الببلاوى يكتب: بين الليبرالية واليسار.. و(حاكم غشوم خير من فتنة تدوم)
- طوابير المشاركين فى الاستفتاء الأخير .. الخطوة الأولى نحو البناء الديمقراطى تصوير : فادى عزت Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; علينا أن نتذكر أن كثيرا من المصطلحات السياسية المعاصرة قد ولدت فى بلاد الغرب نتيجة لما لحق مجتمعاتها من تطورات سياسية واجتماعية كأثر للثورة الصناعية وما أفرزته من تغييرات عميقة فى شكل الحياة الاجتماعية وبالتالى فى نظم الحكم. فقبل الثورة الصناعية كان العالم تغلب عليه المجتمعات الزراعية. وهى مجتمعات تتميز بالاستقرار والتغيير البطىء وغير الملموس، وحيث تسيطر التقاليد والعادات على مختلف مناحى الحياة. وجاءت الصناعة فقلبت الموازين، فكل شىء يتغير، وكل يوم نتعامل مع جديد ليس لنا معه سابق معرفة أو خبرة. فمع بداية الثورة الصناعية ظهرت المدن الصناعية والتى نزعت العمال من جذورهم الريفية إلى مراكز صناعية جديدة ظروف حياتية مختلفة. كذلك فإن الصناعة لا تبقى الأشياء على ما هى، بل هى فى تطور مستمر. فظهور تقنيات جديدة وأساليب مستحدثة، واستخدام مواد أولية متنوعة، أدى إلى تغيير مستمر ليس فقط فى شكل الصناعة أو فى طريقة عملها، وكل يوم تظهر سلع جديدة لم تكن معروفة، كما تختفى أخرى كانت مستخدمة لأجيال. وهكذا جاءت الصناعة بعالم التغيير والتجديد فيه هو أهم معالمه، ولذلك فى مواجهة عالم قديم قائم على التقاليد والاستقرار والتخوف من الجديد وغير المألوف. ولم يكن غريبا، والحال كذلك، أن تصاحب الثورة الصناعية ثورة مقابلة فى الأفكار السياسية والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية السائدة. فإزاء عالم يتغير كل يوم، تظهر مطالبات جديدة، ومصالح لم تكن معروفة تسعى لاكتساب موضع قدم فى العالم الجديد، وبالمقابل هناك مصالح قديمة تخشى الجديد وتحاول الدفاع عن أوضاعها العتيقة. وهكذا بدأ ظهور ما يسمى بالفكر «المحافظ» الذى يدافع عن حماية التقاليد والقديم والتراث، فما يصون المجتمع إنما هو المحافظة على ثوابتها وعدم المغامرة بأفكار أو توجهات جديدة قد تكون ضارة أو قد تنطوى مخاطر غير محسوبة، وهذا هو الفكر المحافظ. وعلى العكس من ذلك، قام فى مواجهة هذا الفكر اتجاه مضاد يرى أن تغير الظروف يتطلب تغير المفاهيم. فنحن إزاء قضايا مختلفة وأوضاع مستحدثة ولابد من فكر جديد وأساليب مختلفة لمواجهة هذه الأمور المستجدة. وهكذا عرف معظم هذه الدول اتجاهين متعارضين: اتجاه تقليدى محافظ يطالب بالحرص على القديم وعدم تعريضه لمخاطر التجديد، واتجاه ثورى يطالب بالتغيير والتطور لملاحقة التغيرات المجتمعية وما يترتب عليها من مشكلات جديدة لم تكن معروفة فى الماضى، أو لم تكن معروفة بهذه الأهمية. وقد أخذت هذا الاتجاهات أشكالا متعددة عرفت فيها أحيانا باسم الاتجاهات الليبرالية، وفى أحيان أخرى باسم اليسار، ورغم أنهما فى معظم الأحيان يعارضان الفكر المحافظ، فكثيرا ما بدا أنهما على خلاف فيما بينهما أيضا. فأين الحقيقة؟ فما هو الفكر الليبرالى؟ وما هو اليسار؟ وهل يختلفان أم أنهما كثيرا ما يتلاقيان؟ هذه أسئلة تستحق المناقشة. بداية الليبرالية: الفكر الليبرالى وثيق الصلة بالديمقراطية، ولكنه يمثل مرحلة متقدمة منها. فالديمقراطية قد عرفت منذ عهد الإغريق، وهى حكم الأغلبية، فالشعب يحكم نفسه بنفسه من خلال الديمقراطية المباشرة ثم من خلال الديمقراطية النيابية بعد أن زادت أعداد البشر. ولكن «الليبرالية» جاءت للتأكيد على أولية حقوق وحريات الإنسان. فحكم الأغلبية يمكن يتضمن الاعتداء على الحقوق الأساسية لبعض الأفراد، وهذا غير جائز أو مقبول فى المفهوم الليبرالى. فديمقراطية أثينا فى حضارة الإغريق، لم تمنع من أن المواطنين الأحرار فى هذه المدينة والذين يباشرون الحرية السياسية لم يزد عددهم على عشرين ألف مواطن أثينى، مقابل أكثر من مائتى ألف من العبيد والأجانب الذين ليست لهم أية حقوق. كذلك فقد كانت الحرية معترفا بها للرجال دون النساء. ومن هنا جاءت نقطة البدء فى الليبرالية فى التأكيد على أولوية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. وللغرابة فقد كان أول من طرح قضية الحقوق الأساسية للأفراد هو الإنجليزى توماس هوبز Hobbes، حيث رأى أن الجماعة تشكلت عندما اكتشف الأفراد أن حياة الوحشية البدائية تهدد كل حقوق الأفراد، فظهرت المجتمعات البشرية وحيث يتنازل كل فرد عن جزء من حريته للملك أو الحاكم الذى يتمتع بالسلطة فى نوع من «العقد الاجتماعى»، لضمان باقى حقوق الأفراد. وقد انتهى هوبز من بحثه عن حماية حقوق الأفراد إلى نتيجة غير متوقعة وهى تأييد سلطة الملكية المطلقة. فهذه السلطة المطلقة هى التى تحمى حقوق الأفراد، وأنه لا يجوز، بالتالى، التمرد عليها خوفا من العودة من جديد إلى حالة الوحشية والفوضى وحيث تضيع كل الحقوق. وهو موقف لا يختلف كثيرا عن موقف بعض فقهاء المسلمين الذين دافعوا عن سلطة ولى الأمر وعدم جواز الخروج عليه خوفا من الفوضى (الفتنة). «فحاكم غشوم خير من فتنة تدوم» على قول بعض الفقهاء. فالهاجس الأساسى لهوبز ومن وافقه هو أن الأمن والاستقرار هما أهم مقومات الحياة فى المجتمعات. وهو مبرر استخدمته بعض النظم الاستبدادية للتخويف من مخاطر التغيير بمقولة حماية الأمن والاستقرار. وجاء بعد ذلك جون لوك Lock، وهو المؤسس الحقيقى لمفهوم «الليبرالية»، مؤكدا أن «العقد الاجتماعى» الذى يربط الأفراد للعيش فى المجتمع والخضوع للقوانين، لا يمنع الثورة وخروج الأفراد على الحاكم المستبد إذا أخل بالتزامه فى احترام وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. فللأفراد حق الثورة على الحاكم الظالم وفسخ «العقد الاجتماعى» معه، ولا خوف من الثورة عليه، لأن البديل للحاكم المستبد ليس العودة إلى حالة الفوضى والوحشية كما تصور هوبز، وإنما البديل للاستبداد هو الحكم الدستورى الذى يحترم حقوق وحريات الأفراد. وهكذا كان جون لوك داعية للثورة الدستورية، وفى زمنه قامت الثورة المجيدة (1688) Glorious Revolution فى إنجلترا والتى أسست للملكية الدستورية. وبذلك ظهر مفهوم «الديمقراطية الليبرالية». فالديمقراطية وفقا لذلك المفهوم ليست مجرد حكم الأغلبية، وإنما هى أساسا احترام حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم، ولا تعدو الانتخابات والأحزاب والمجالس النيابية سوى إجراءات وتنظيمات من أجل احترام وحماية هذه الحقوق والحريات الأساسية. فليست «ديمقراطية ليبرالية» تلك النظم التى تنتهك بعض الحقوق والحريات ولو باسم الأغلبية. فالحقوق الأساسية للأفراد حقوق سابقة على وجود المجتمعات نفسها، ووجود هذه المجتمعات يجد تبريره فى أنها توفر الحماية والضمان لهذه الحقوق والحريات. وبطبيعة الأحوال، فإن حقوق كل فرد وحرياته مقيدة بضرورة احترام حريات الآخرين. وهكذا نجد أن مفهوم الديمقراطية الليبرالية يمثل تقدما على المفهوم التقليدى للديمقراطية عند الإغريق والذى يعتمد على حكم الأغلبية فقط. فالأغلبية دائما على صواب ــ فى هذا المفهوم القديم ــ حتى وإن تعرضت للحقوق والحريات لبعض الأفراد أو الأقليات. ولذلك لم يكن غريبا أن كبار الفلاسفة الإغريق كانوا أقل ثقة فى الديمقراطية الإغريقية، حيث إنها كثيرا ما كانت حكما للغوغاء بأكثر مما هى احترام لحرية الفرد باعتباره إنسانا. وكثيرا ما شاهدنا فى العصر الحديث جرائم ارتكبت باسم الأغلبية أو نوعا من الأغلبية. فإذا كان النظام النازى فى ألمانيا لم يحصل على أغلبية البرلمان، فقد كان أكبر الأحزاب وأكبرها تمثيلا فى المجلس النيابى، وعندما وصل هتلر إلى الحكم وبدأ فى اضطهاد الأقليات، فقد تم ذلك بتأييد من الأغلبية الشعبية. كذلك فإن مجازر يوغوسلافيا بعد تفككها لم تكن بدون مساندة من أبناء الصرب أو الكروات. الأغلبية هى أساس الحكم فى النظام الليبرالى، بشرط أن تحترم الحقوق والحريات للجميع. ظهور اليسار استعرنا تعبير «اليسار» و«اليمين» من التقاليد الأوروبية فى مجالس الحكم. فكان الملك يجمع حوله مجالس للحكم للاستئناس بآرائهم، ولم تلبث أن تحولت هذه المجالس بشكل تدريجى لتصبح مجالس تمثيلية تنتخب أو تختار من فئات محدودة أول الأمر، ثم فى جموع الشعب بعد ذلك، وكانت الأساس فى ظهور البرلمانات. وجرت العادة فى هذه المجالس، خاصة فى انجلترا وفرنسا، أن يجلس الموافقون على جانب على «اليمين» والمعارضون على «اليسار». وهكذا أصبح مفهوم «اليمين» هو أنصار «المحافظة» على الأوضاع القائمة وتأييد الحاكم، كما أصبح «اليسار» هو أنصار المطالبين بالتغيير ومعارضة الحكومة. وفى انجلترا، وهى أم الديمقراطيات الحديثة، كان الحكم مستقرا فى العائلات المالكة ويحيطها النبلاء من أصحاب الأراضى الزراعية الشاسعة. ومع بداية الثورة الصناعية بدأت تظهر فئات جديدة من العاملين فى هذا الميدان الجديد للصناعة والتجارة والأعمال الحرة والتى بدأت تنازع طبقة النبلاء المستندين إلى الملكيات الكبيرة للأراضى الزراعية الواسعة. وكان هؤلاء النبلاء هم المدافعون بشكل عام على حماية الأوضاع القديمة، فهم المحافظون Tories أسلاف حزب المحافظين البريطانى الحالى، فى حين كان الأحرار (الليبرالية) Whigs هم ممثلو الطبقات الجديدة خاصة من التجار والصناعيين وأصحاب المهن الحرة، والمطالبين بالتغيير وبالديمقراطية الليبرالية. وهكذا بدأت «الليبرالية» كأحزاب «يسار» ومعارضة تطالب بالتغيير والتحرر من سيطرة طبقة النبلاء وكبار الملاك المزارعين المطالبين بحرية التجارة وحرية التعبير وحرية الانتقال. وقامت الثورة الفرنسية كأكبر حركة يسارية فى ذلك الوقت رافعة شعار «الحرية والمساواة والإخاء». وهكذا كانت الديمقراطية السياسية هى المطلب الأول لليسار. على أن اليسار لم يتوقف عند المطالبة بالديمقراطية والحقوق السياسية، فتطور الثورة الصناعية ما لبث أن أبرز المظالم الاقتصادية التى تعرض لها العمال فى مراحل الرأسمالية الصناعية الأولى، من استغلال الأطفال والنساء وتدهور أحوال العمال المعيشية وانخفاض أجورهم وتعرضهم للمخاطر وعدم توافر أية حماية اجتماعية لهم. ومع منتصف القرن التاسع وخصوصا بعد نشر الإعلان الشيوعى لماركس وأنجلز 1848، أخذ اليسار منحى جديدا ــ مع الماركسية ــ فى الدفاع عن حقوق العمال ومهاجمة الرأسمالية وفكرة الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج، وأن الحل هو الأخذ بالاشتراكية بإلغاء الملكية الخاصة ــ فى أموال الإنتاج ــ وإقامة المجتمع الاشتراكى القائم على دكتاتورية البروليتاريا. وفى نهاية العقد الثانى من القرن العشرين قامت الثورة البلشفية فى روسيا، وقام أول نظام اشتراكى ماركسى، وما لبث أن توسع المعسكر الاشتراكى وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث امتد إلى وسط وشرق أوروبا ثم الصين. وأصبح المعسكر الاشتراكى أحد القطبين العالميين، وقامت الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكى والغربى. وبعد سبعة عقود انهار النظام الاشتراكى. وإذا كانت الاشتراكية الماركسية قد قضت على الملكية الخاصة فى أدوات الإنتاج، فإن الدولة قد أصبحت ــ فى ظل هذا المذهب ــ هى المالك الوحيد فى نظام أقرب إلى «رأسمالية الدولة». لقد أصبحت الدولة هى الرأسمالى الوحيد كما هى الحاكم المطلق، وبذلك احتكرت السياسة والاقتصاد معا. وقد حقق الاتحاد السوفييتى خلال العقود الأولى تقدما صناعيا هائلا، وإن صاحبته تضحيات إنسانية هائلة أيضا، ثم عرف فى العقود الأخيرة ترهلا اقتصاديا. وباستثناء القوة العسكرية الرهيبة، فقد تحول الاتحاد السوفييتى إلى كيان سياسى واقتصادى أجوف، وانهار النظام مؤخرا فى شبه مفاجأة للجميع وتكشّف الأمر عن مظاهر الوهن الاجتماعى والاقتصادى للنظام الشمولى القامع للحريات الفردية. وقد ظهرت، فى نفس الوقت، فى معظم الدول الأوروبية أحزاب يسارية أخرى لم تذهب إلى حد إلغاء الملكية الخاصة وإنما بالمطالبة بتأميم المشروعات الكبرى وزيادة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى. ولم تعد مطالب «الحرية» هى وحدها أساس دعوات اليسار وإنما احتلت «المساواة» دور الصدارة فى المطالبات السياسية لليسار. فالحرية السياسية التى نادى بها أنصار الديمقراطية الليبرالية لم تعد كافية فى نظر اليسار، بل إنها كانت ــ فى نظرهم ــ مجرد حريات نظرية بلا مضمون حقيقى. فالحرية الحقيقية ليست مجرد مساواة فى الفرص أو مساواة أمام القانون، وإنما هى أيضا مساواة فى الواقع الاقتصادى. وهكذا ظهرت إلى جانب هذا اليسار الماركسى حركات اشتراكية ديمقراطية تقبل باقتصاد السوق وتنادى بضرورة الديمقراطية والحريات العامة مع مزيد من تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية. وقد عرف مفهوم «الليبرالية» فى الفترات الأخيرة تفاوتا ملحوظا بين الولايات المتحدة وبين أوروبا. فعلى حين يقصد بالليبرالى فى الولايات المتحدة من يطالب بتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية بشكل متزايد لأهداف اجتماعية، كما كان الأمر مع روزفلت أو حتى مع كلينتون أو أوباما. فإن المحافظين الأمريكيين يرفضون كل تدخل للدولة، وإن كانوا أشد المطالبين بالدعم الحكومى لأسواق المال فى الأزمة المالية الأخيرة مع بوش الابن. أما فى أوروبا، فإن من يعرف «بالليبراليين الجدد»، فإنهم من يعارضون التدخل بشكل عام فى اقتصاد السوق. وهؤلاء الليبراليون الجدد فى أوروبا هم أقرب إلى المحافظين التقليديين منهم إلى الليبرالية الأصلية. أما الأقرب إلى مفهوم الليبرالية فى أوروبا الآن فيظهر فيما يعرف بنظام «اقتصاد السوق الاجتماعى» خاصة فى ألمانيا.فى الحرية والمساواة يتضح مما تقدم أن مسيرة الإنسان للتحرر قد قامت ـ بشكل عام ـ على المطالبة «بالحرية والمساواة». وتتطلب الحرية الاعتراف بحقوق أساسية للفرد لا يجوز المساس بها، وله أن يشارك فى الحكم وأن يختار حكامه ويخضعهم للمساءلة. ولكن الحرية السياسية وحدها لا تكفى بل لابد وأن تتوافر له حدود معقولة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبما يجعل هذه الحريات حقائق وليس مجرد حقوق نظرية. ومن هنا فإن دعوات المساواة التى دعت إليها المذاهب الاشتراكية لابد أن تجد مكانها. وهكذا تصبح الحرية والمساواة دعوات إنسانية يجب العمل من أجل توفيرها. فلا يستطيع أحد أن يجادل فى أن الحرية والمساواة هما من أهم مكتسبات الحضارة الإنسانية، وأنه لا تقوم قائمة لمجتمع متحضر وتقدمى فى غيبة أحدهما أو كليهما. وفى مقال نشرته فى جريدة الأهرام بتاريخ 26 يونيو 1973 بعنوان «فى الحرية والمساواة» ثم فى كتاب لى صدر بنفس العنوان عن دار الشروق 1985 انتهيت إلى أنه، «مع الاعتراف بأن الحرية والمساواة معا هما أعمدة أى نظام سياسى ناجح، إلا أن الحرية هى الأساس وينبغى أن يكون لها دائما الأسبقية. وليس المقصود بالحرية هنا فقط أشكال الحكم الديمقراطى وسيادة القانون بل أيضا الاعتراف بحقوق أساسية للفرد لا يمكن المساس بها ولو بموافقة الأغلبية. فللفرد، باعتباره إنسانا، حقوق سابقة تحمى وجوده وفكرة عقائده ومشاركته فى الجماعة، لا يمكن المساس بها على أى وجه من الوجوه». وليس الأمر مجرد تفضيل شخصى بل إنها نتيجة تجربة تاريخية طويلة. «فنظرة منصفة إلى النظم السياسية المختلفة تقطع بأن الدول التى قامت على مبدأ الحرية ودعت إليها لم تنجح فقط فى توفير قدر كبير من الحرية ــ كل شىء نسبى طبعا ـ ولكنها وفرت أيضا مكاسب ضخمة على طريق المساواة... وعلى العكس من ذلك، فإن النظم السياسية التى قامت أساسا على مبدأ المساواة قد فشلت جميعا ـ تقريبا فى تحقيق الحرية ولم تنجح فى كثير من الأحوال فى تحقيق المساواة». والآن، وبعد نحو أربعين عاما على ما سطرته عن «الحرية والمساواة»، أرى أننا أحوج ما نكون إلى نظام ليبرالى يقوم على احترام الحقوق والحريات مع وعى وإدراك بأهمية النواحى الاجتماعية فى المساواة والعدالة.






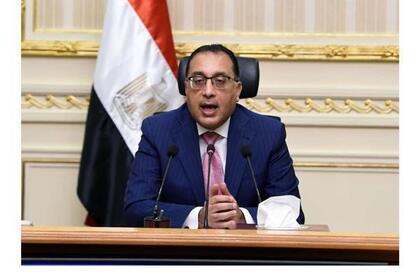


Comments